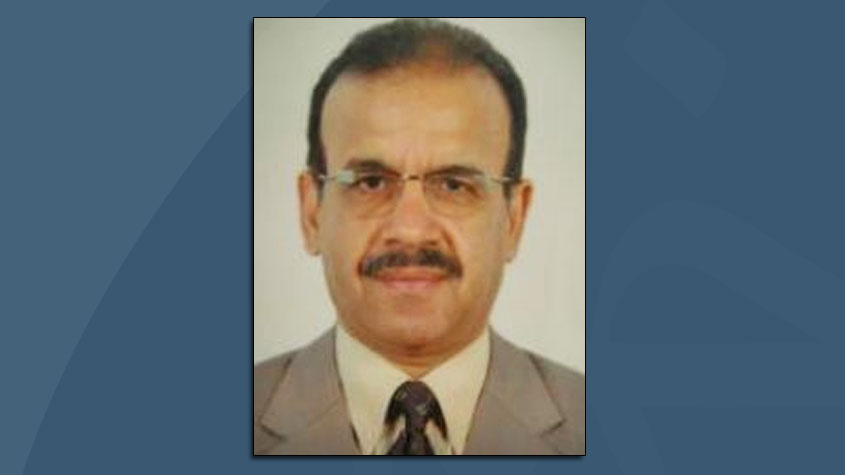ماذا تبقى من «العلمانية» و«الديمقراطية» في تركيا؟
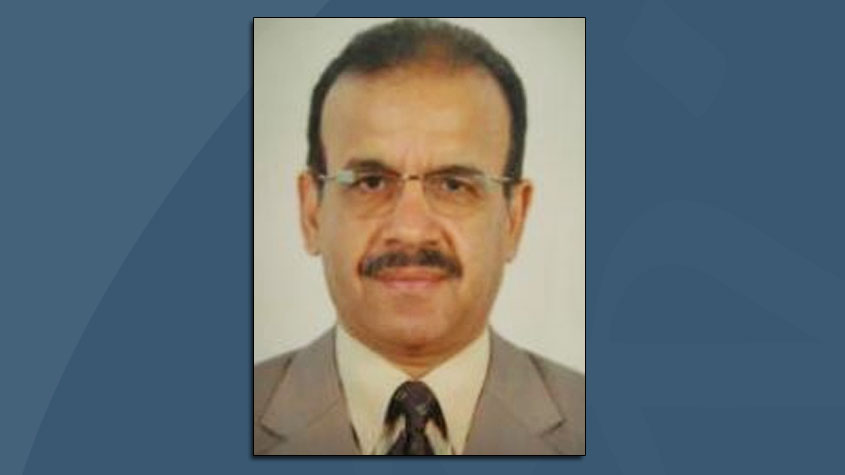
رضي السماك ..
صمم كمال أتاتورك مؤسس النظام الجمهوري التركي سنة 1924، الذي ورث النظام الإمبراطوري الثيوقراطي العثماني، صمم نظامه على أسس تحاكي شكلياً الأنظمة العلمانية الغربية بدون تعددية حزبية مفتوحة، فأسس حزب الشعب الجمهوري بوصفه حزباً وحيداً في البلاد، وحتى التعددية الحزبية التي جاءت بعد رحيله كانت تعددية قومية علمانية محدودة في إطار النخبة الحاكمة تتناوب السلطة وفق اللعبة المصممة سلفاً، وكانت منبثقة من الحزب الحاكم، كالحزب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، ولم يكن مسموحاً للأحزاب اليسارية والإسلامية بالتشكيل، ولا بالمشاركة في الانتخابات تحت أي غطاء، وإن كان الموقف من التيارات الإسلامية أقل تشدداً في فترة المد اليساري، فسُمح لنجم الدين اربكان بإنشاء حزب إسلامي في مطلع السبعينات «حزب النظام الوطني» والذي تعددت تسمياته بعدئذ، تارةً تبعاً للعبة السياسية والمناورة في الحفاظ على وجوده كلاعب مقبول على ملعب الحياة السياسة، وتارةً أخرى تبعاً لانشقاقاته.
وفي العقود الأولى من تأسيس الجمهورية، خلال فترة المد اليساري العالمي، استشعر النظام العلماني المتحالف مع الغرب في «الناتو» بأن الحركات اليسارية وعلى وجه الخصوص «الحزب الشيوعي التركي» هي الخطر الأكبر عليه، وقد واجهت هذه الحركات منذ تأسيس النظام على الدوام قمعاً وحشياً ممنهجاً. ومع صعود التيارات الإسلامية العالمية بعد نجاح الثورة الإيرانية 1979 استشعر النظام العلماني بأن التيار الإسلامي هو الخطر يواجهه وينازع النخبة الرأسمالية العلمانية الحاكمة بمختلف تلاوينها، وكانت المؤسسة العسكرية تُعتبر هي الحامية للشرعية لعلمانية الدولة بصيغتها الديمقراطية «الشكلانية»، وبخاصة بعد نجاح الجيش العام 1960 بانقلابه العسكري على رئيس الحكومة المُنتخب عدنان مندريس لمجرد أن ظهرت عنده بعض بوادر الميول الإسلامية، على رغم أنه ينحدر أساساً من الحزب الجمهوري العلماني الذي أسسه أتاتورك، ولم تنفع كل تأكيداته المتكررة قبل الانقلاب بأنه «علماني» ويحترم نظام الدولة العلماني. كما حُكم أيضاً على رئيس الجمهورية حينذاك محمود جلال بايار بالسجن مدى الحياة، ونجح الجيش أيضاً في اقصاء أربكان رئيس الوزراء الإسلامي زعيم حزب الرفاه في أواخر التسعينات من السلطة وتم حل حزبه، كما تم حل وريثه حزب «الفضيلة» .
ومع أن المؤسسة القضائية كانت متساوقة ومنسجمة دائماً مع المؤسسة العسكرية في حماية النظام «العلمانية» من أي اختراق للإسلاميين، إلا أنها بدت في مطالع الألفية الثانية تفقد زمام المبادرة في الحيلولة دون اختراق الإسلاميين للجدار الفولاذي الذي شيّده النظام منذ تأسيسه لصدهم اليساريين، فقد نجحوا بذكاء، استناداً إلى خبرتهم المديدة في اللعبة والمراوغة السياسيتين، في الوصول إلى البرلمان بغالبية مكنتهم من تشكيل حكومة بمفردهم من خلال حزبهم الجديد «التنمية والعدالة» في انتخابات 2002. وعلى رغم ما كان يُتوقع أن يحدث انقلاب جديد يزيحهم من الحكم كالحالات السابقة إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تمكن الحزب الإسلامي الجديد الحاكم من التغلغل ليس في المؤسسات المدنية للدولة فحسب بل وفي أدق مفاصل 3 مؤسسات حساسة مهمة ألا هي: المؤسسة العسكرية، والمؤسسة الأمنية والإستخباراتية، والمؤسسة القضائية، وبدا أن مؤسسة الجيش التي اُنهكت سياسيا من المشاكل الداخلية المزمنة، ونالت سمعة سيئة من الانقلابات القمعية المتعاقبة ومصادرتها الحريات العامة، بدت عاجزة عن وضع حد لهذا الاختراق، وتزامن ذلك مع ترهل أيضاً رديفتها الاوليجاركية العلمانية المدنية التي تفاقم انحسار شعبيتها هي الأخرى، في ظل معاناتها من أمراض الشيخوخة وتقدم عتاة جنرالاتها في السن، وهكذا تكرر نجاح «حزب التنمية» بعدئذ في الفوز بالانتخابات النيابية والرئاسية، مما مكّنه من اجراء تغييرات واسعة في قواعد اللعبة السياسية، وأصبح النظام من حيث الجوهر إسلاموياً شعبوياً براغماتياً شمولياً بامتياز و»علمانياً» من حيث الشكل، وأصبح رئيسه رجب طيب أردوغان سلطاناً عثمانيا متوجاً ببزة أفندية معاصرة بدون عمامة السلطان التقليدية.
الآن يمكننا القول في ظل قراءة التداعيات المتوالية المتسارعة لفشل الانقلاب العسكري إن «العلمانية» و»الديمقراطية» الشكلانيتين للنظام القائم واللتين أرساهما أتاتورك منذ تأسيسه قبل 82 عاماً أضحتا بكل معنى العبارة في «مهب الريح»، وهذا ما دفع أوساط ودول غربية نددت بالانقلاب لإبداء احتجاجاتها على الإجراءات القمعية الواسعة النطاق بقوى المعارضة داخل مؤسسات النظام وخارجها، وفي عدادها كثرة من الأبرياء اللامنتمين المشكوك في ولائهم لرئيس الجمهورية والحزب الحاكم.
وبحسب المعطيات المتوافرة، حتى ساعة إعداد هذا المقال، ففي خلال 48 فقط من إفشال الانقلاب تم اعتقال ما يقرب من 8 آلاف شخص معظمهم من العسكريين، وما يقرب من 2500 قاضٍ، 100 شرطي، وتم تسريح اكثر من 9 آلاف موظف من وزارة الداخلية، هذا عدا الاعتقالات التي طالت مئات المدنيين من مختلف وزارات الدولة وأوساطاً ورموزاً إعلامية وثقافية وسياسية. واضطرت حملة الاعتقالات الجنونية غير المسبوقة في تاريخ تركيا الحديث دولاً وأوساطاً غربية إلى استنكارها على رغم تنديدها بالانقلاب الفاشل قبلاً، وبخاصة إثر عدم تورع أردوغان عن أبداء نهمه الشديد غير مرة، لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها دول ديمقراطية كثيرة في العالم الغربي الحر، ويتجه المزيد من الدول للاقتداء بها في إلغائها، كما بدا تبريره التوسع الهائل في الحملة بأن ضحاياها العسكريين والمدنيين جميعهم خونة من أتباع الداعية فتح الله غولن ممجوجاً، وهكذا فلم يتردد يوهانس هان، مفوّض الاتحاد الاوروبي عن اعتبار قوائم الاعتقالات مُعدة سلفاً قبل الانقلاب، وكذلك حذرت وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني في ضوء الانتهاكات الفظة التي ارتكبها أنصار أردوغان المتظاهرون في الشوارع بحق الانقلابيين الأسرى، وفي ظل توسع حملة القمع... حذرت من عدم احترام سيادة القانون أو الاستخفاف بمبدأ الفصل بين السلطات، ولم يتردد وزيرا خارجية فرنسا وبلجيكا عن إبداء تصريحات بهذا المعنى، ناهيك عن أوساط دولية كثيرة في العالم.
ما معنى كل ذلك؟ ليس من معنى مستخلص من كل تلك الحوادث الأخيرة وخلفياتها السياسية التاريخية الآنفة الذكر، سوى أن تركيا باتت تعيش الآن عصر «الأردوغانية» بطابعه الشمولي الشعبوي تحت مسمى نظام علماني اسماً، بل وقد باتت الفرصة سانحة للتخلص حتى من هذا المُسمى، ولا معنى لذلك أيضاً سوى أن «العلمانيين» الحقيقيين والأتاتوركيين والديمقراطيين عامةً، إنما يدفعون الآن ثمن صيغة العلمانية والديمقراطية «الشكلانيتين» التي أرساهما أتاتورك وخلفاؤه المؤسسون الأوائل، وما حدث ويحدث ما هو إلا نتاج لإقصاء ممنهج ساد مرحلة تاريخية طويلة من عمر النظام الجمهوري، بإقصاء القوى الديمقراطية واليسارية والإسلامية المستنيرة، وهو أيضاً نتاج من نفاق الغرب المطبل لديمقراطية هذا النظام الواعد وصمته المخزي عن عهوده الانقلابية العسكرية الدكتاتورية، مادام حكم العسكر ملتزماً بتحالفه مع الغرب في إطار «حلف الناتو»، ومادام هذا النظام هو ضامن مصالحه الإستراتيجية والاستثمارية داخل تركيا، حتى لو اعتلاه سدة الحكم إسلاميون غير علمانيين وغير ديمقراطيين في مسلكياتهم؛ بل ويحظون بتسويق واشنطن لهم كنموذج مُلهم لوصول الإسلاميين المسالمين غير المتشددين في العالم العربي!
صحيفة الوسط البحرينية
أضيف بتاريخ :2016/07/24