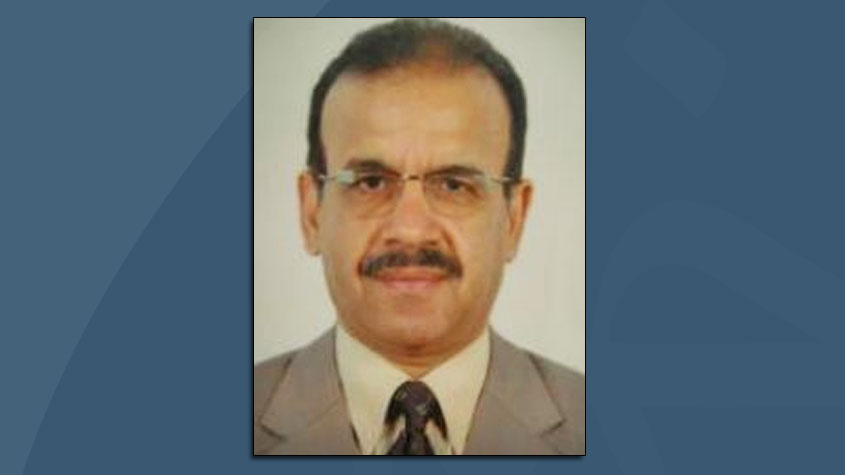بين النكبتين الفلسطينية والمصرية
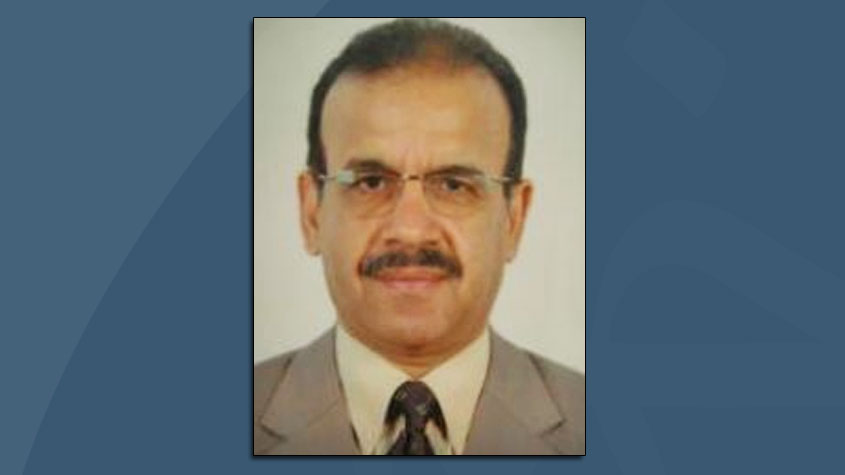
رضي السماك
عادةً ما يرتبط يوم 15 مايو/ أيار في الذاكرة الجمعية القومية بذكرى كارثة اغتصاب فلسطين العربية على أيدي العصابات اليهودية الصهيونية المسلحة في العام 1948، ولذلك أعتاد الإعلام العربي عامةً في هذه المناسبة من كل عام تناول هذه الذكرى الأليمة من زوايا مختلفة، إما من خلال البهرجة الموسمية الإنشائية المعتادة لرفع العتب عن التقصير كما دأب الإعلام الرسمي العربي على ذلك، وإما من خلال زوايا تحليلية سياسية متعددة كما يفعل الكتّاب العرب الذي يتحلون بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والضمير الحي فيحللون ما تركته ومازالت تتركه «النكبة» من تداعيات كارثية متوالدة ليس على الصعيد الفلسطيني العربي فحسب؛ بل على الصعيد العربي برمته باعتبارها - النكبة - تُعد بحق اُم الكوارث والنكبات العربية.
لكن لا أحد يتذكّر أن 15 مايو/ أيار يرتبط أيضاً بذكرى أخرى هي أشبه بـ «النكبة السياسية»، إن جاز التعبير، وقد وقعت في العام 1971 بعد مرور أقل من عام على رحيل الرئيس المصري جمال عبدالناصر (ت 1970) وتولي نائبه الرئيس الراحل أنور السادات مهام رئاسة الجمهورية خلفاً له، وتتمثل في الإنقلاب السياسي الذي نفذه السادات على الجناح الناصري اليساري داخل السلطة والمناوئ لسياساته اليمينية التهادنية مع إسرائيل وأميركا التي ظهرت بوادرها مبكراً منذ تسنمه الحكم، وأبرز وجوه هذا الجناح علي صبري نائب رئيس الجمهورية والفريق محمد فوزي وزير الحربية ومحمد فائق وزير الإعلام ومحمد لبيب شقير رئيس البرلمان وسامي شرف وزير شئون الجمهورية وغيرهم، وقد أزاحهم بجرة قلم مع أنهم من أبرز أركان حكم عبدالناصر وأوثق رجالاته إليه. وعلى الرغم من مرور أكثر من 45 عاماً على ذلك «الانقلاب» فإن لا أحد حتى اليوم من الكتّاب والباحثين المصريين والعرب قد تناول كلتا النكبتين، الفلسطينية والمصرية، في سياق تحليلي واحد مترابط وليس في سياقين منفصلين، إذ على الرغم من ما يبدو عليه الأمر للوهلة الأولى بعدم وجود رابط سياسي بينهما، فإن الحدث المصري إذا ما تمعّنا جيداً فيه من جميع أبعاده ونتائجه ذو صلة جوهرياً في جانب كبير من جوانبه بالقضية الفلسطينية، وذلك لما تركه ومازال يترك هو الآخر تداعيات سياسية مدمرة على الساحتين العربية والمصرية معاً.
ذلك بأن ضيق صدر السادات ذرعاً بآراء رفاقه من اليسار الناصري في الاتحاد الاشتراكي (التنظيم السياسي الحاكم) المعارضين لتوجهاته، ونزعاته اليمينية والتي استشعروها فيه وإقالتهم من مناصبهم المهمة، وزجهم جميعاً في المعتقلات في منتصف مايو/ أيار 1971 قد مكّنه بعدئذٍ من التفرد الكامل بالسلطة المطلقة، وتنفيذ أجندته السياسية التي حاول أن يخفيها في مستهل حكمه، ومنها المراهنة على أميركا في تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، ووصفها بأنها وحدها التي تملك 99 في المئة من أوراق اللعبة، لتسوية هذا الصراع مع إسرائيل، وتطبيقاً لنظريته هذه فإنه لم يتورع بعدئذ عن عقد صفقة سياسية منفردة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة ذاتها في العام 1978 عُرفت باتفاقيات كامب ديفيد التي قدم بموجبها تنازلات هائلة، فاقت توقعات حتى أكثر رموزه في السلطة يمينيةً كما عبروا بعدئذ في مذكراتهم بعد تقاعدهم. أما على الصعيد المحلي وفي سياق تطبيقه لسياسة «الانفتاح الاقتصادي» والذي انطلق في تنفيذه بُعيد حرب 1973 مُباشرةً بدون أي ضوابط، فقد قام السادات بالإجهاز تباعاً على كل المكتسبات والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية التي حققها سلفه عبدالناصر لصالح العمال والفلاحين والفقراء والمحرومين وذلك من خلال بيع مؤسسات القطاع العام بأثمان بخسة للطبقة الطفيلية الجديدة الصاعدة، ما أدى إلى توسع التفاوت الطبقي الحاد في المجتمع، وزيادة الفقراء فقراً وزيادة الأغنياء غناً، وهذه السياسة الساداتية ما انفكت مصر - كما يعلم الجميع - تعاني من تبعاتها الكارثية باطراد إلى يومنا هذا.
وإذا كان عزاؤنا في نتائج نكبة 1948 العسكرية السياسية الفلسطينية، أنها عمّقت من وعي العرب بذاتهم القومية وكانت واحدة من محفزات إقامة أنظمة «وطنية « قامت على إثر انقلابات عسكرية بررتها ضمن ما بررت بتلك النكبة التي خذلتها أنظمة فاسدة، فإننا لا نجد أي عزاء أو سلوان في نكبة مصر السياسية 1971، ذلك بأنها سرعان ما مهدت لاحقاً إلى إخراج مصر نهائياً من حلبة الصراع العربي - الإسرائيلي، وأفضت إلى اختلال ميزان القوى بين مصر ودول المواجهة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية وخلافها، وذلك لأن نكبة مايو/ آيار 1971 هي التي مهدت الأرضية لتوقيع السادات اتفاقات كامب ديفيد لاحقاً، وأرست بالتالي «القدوة» السياسية التاريخية لاستباحة تابوهات سياسية ظلت مُقدسة طوال ثلاثة عقود بالتمام والكمال (1948 - 1978) لا تجرؤ الأنظمة العربية كافةً بانتهاكها، فإذا بنا اليوم بدول عربية كثيرة تنخرط بلا حياء في التطبيع المجاني مع العدو الإسرائيلي، وعقد الصفقات المنفردة معه بعدما كانت تُعقد في الخفاء وتنفيها إثر افتضاحها، فغدت تُمارس علانيةً على المكشوف بالمجاهرة باعتبار إسرائيل أضحت أقل خطورةً على «الأمن القومي العربي» من ما تشكله بعض القوى الإقليمية الأشد خطورةً عليه، وللتحالف معها لمواجهة هذا العدو المشترك!
صحيفة الوسط البحرينية
أضيف بتاريخ :2017/05/16