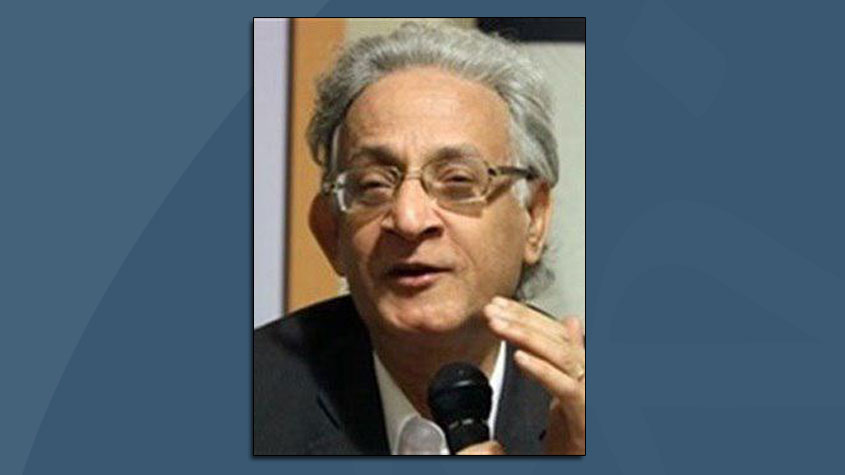السوريون في مصر: إعادة اكتشاف البديهيات
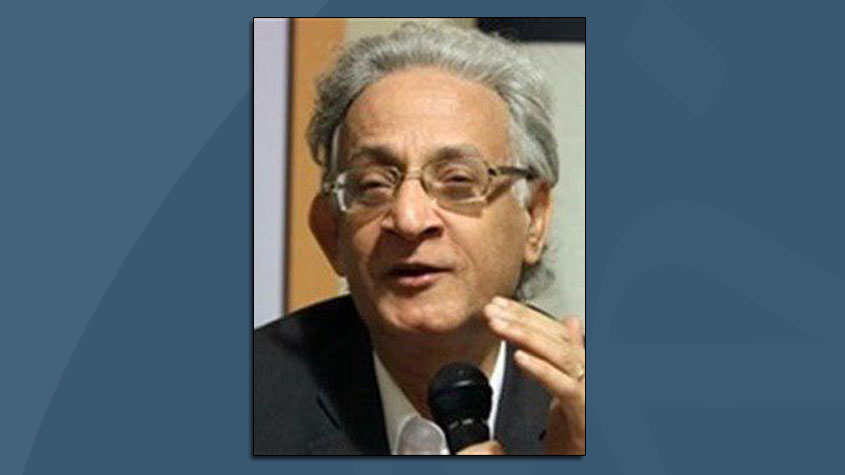
عبدالله السناوي
يُقال عادة: «لا حرب بلا مصر ولا سلام بلا سوريا»، وقد ثبتت صحّة القول في مسار الصراع العربي ــــ الإسرائيلي وتعرجاته. بحقائق الجغرافيا السياسية، إذا ما سقطت سوريا تتقوض مصر ويخسر العالم العربي كله أية مناعة تحول دون تفكيك دوله والتلاعب بمصائره. هذه واحدة من بديهيات نظرية الأمن القومي.
بأثر خبرة التاريخ والتجارب التي استقرت في الذاكرة العامة، فإن بديهيات الأمن القومي تثبت حضورها من وقت لآخر، رغم أي ظروف معاكسة. وقد كان الغضب الشعبي الواسع على شبه حملة استهدفت الاستثمار الاقتصادي السوري في مصر وإثارة الشكوك حوله دون سند أو دليل تعبيراً عمّا استقر من حقائق وبديهيات في الوجدان المصري. يصعب وصف الدعوة إلى إخضاع الأموال السورية لرقابة خاصة بالحملة المنظمة، فقد تبنّتها أصوات معدودة على هامش الحياة العامة. من حيث المبدأ العام، فإن هناك قواعد قانونية لسلامة التصرفات المالية يخضع لها المستثمرون العرب والأجانب والمصريون أنفسهم. خرق القواعد بالتعميم العشوائي يضرب في مناخ الاستثمار والقدرة على جذبه بقدر ما يضرب في الأمن القومي والحفاظ عليه. بالأرقام فإن حجم الاستثمارات السورية في مصر يبلغ نحو 800 مليون دولار، أغلبها في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأعداد المسجلين لدى هيئة الاستثمار 30 ألف مستثمر. قيمة مصر التي تكرست في تاريخها الطويل أنها تستضيف ولا تنشئ خياماً ومعسكرات إيواء إنما تتيح أمام من يلجأ إليها فرصاً كالتي تمنحها لمواطنيها بقدر ما تسمح ظروفها. بقوة الرأي العام، مرت الاتهامات المرسلة كزوبعة في فنجان، سحقت شبه الحملة في مهدها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة واحدة «مصر منوّرة بالسوريين».
في الذاكرة العامة إرث طويل من الاتصال الثقافي والفني بين مصر والشام في العصور الحديثة وتداخل اجتماعي وإنساني يوغل في القدم وإرث طويل آخر من الحروب والمصائر المشتركة طلباً للوحدة والمنعة تلخصت ذات يوم في دولة الوحدة المصرية السورية المجهضة. بحكم موقعها الجغرافي، لم يكن ممكنًا لسوريا أن تنغلق على نفسها تحت أي ادعاء، أو أن يكون لها مستقبل خارج عالمها العربي بأية ذريعة.
لم تكن مصادفة أن سوريا ــــ بالذات ــــ هي البلد التي احتضنت الفكرة العروبية في مواجهة «التتريك» ونشأت فيها ــــ قبل غيرها ــــ الحركات ذات التوجه القومي العربي. كما لم تكن بلاغة تعبير أن توصف بـ«قلب العروبة النابض». بحكم موضعها في المشرق العربي، فهي عاصمته الطبيعية. وبحكم اتصال الأمن القومي المصري بها، فهي توأمته. وبحكم حدودها مع الدولة العبرية، فهي طرف في صراع وجودي. وبحكم امتداد ساحلها على البحر المتوسط، فهي مركز استراتيجي. وبحكم اتصالها بشبه الجزيرة العربية، حيث موارد النفط، فهي تحت بصر المصالح الغربية.
أكدت الحقائق نفسها أن لا عالم عربي بلا مصر، التي تمثل ثلث كتلته السكانية، ولا نهضة عربية بلا سوريا ــــ مهما حسنت النيات والتوجهات. المصير السوري هو شأن كل بلد عربي وكل مواطن عربي يدرك حقائق ما حوله. هذا ما أدركه المصريون العاديون في لحظة مواجهة شبه حملة فشلت في دق الأسافين بين الشعبين الشقيقين.
كان الضابط السوري الشاب جول جمال حاضراً بقوة في الغضب العام، كأنه اعتذار جماعي عن الأصوات التي تفلّتت بالإساءة إلى عمق ما يجمع. أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام (1956)، استشهد جول جمال بعدما نسف البارجة «جان دارك». كان يدافع عن سوريا بقدر ما كان يدافع عن مصر.
في عام 1973 خاض الجيشان المصري والسوري حرباً واحدة بتوقيت واحد، وسالت الدماء لمعنى واحد. عندما تشاهد على شرائط مسجلة مئات آلاف البشر تتدافع يوم وصول جمال عبد الناصر إلى دمشق لأول مرة وهو رئيس لجمهورية الوحدة، فلا بد أن تنصت لصوت التاريخ، وتدرك بالعمق أنها كانت تهتف للمعنى قبل الشخص، وأن هذه لم تكن «انفعالات عواطف» بل حقائق تاريخ يجسدها رجال وأحلام سجلتها أغانٍ بأصوات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاح سلام ومحمد قنديل وآخرين. في دمشق، طلب عبد الناصر أن يرى بعينيه نهر بردى، الذي طالما استمع لمحمد عبد الوهاب يغني له. مرة بعد أخرى يسأل، والوفود تتدفق إليه في قصر الضيافة... «متى أرى بردى؟».
عندما أوغل الليل، وجد للرئيس طريق من قصر الضيافة إلى بردى على ضوء المشاعل. إنها قوة الأدب والثقافة في صناعة الوجدان العام، وهذه بديهية مشتركة أخرى تجمع المصريين والسوريين على نحو يصعب فصمه.
في 28 أيلول /سبتمبر 1961، جرى إنهاء الوحدة المصرية ــــ السورية بانقلاب عسكري رعته الاستخبارات الأميركية، وموّلته المملكة العربية السعودية، وشاركت فيه الأردن، وآزرته تركيا، وهللت له إسرائيل. من مفارقات التواريخ أن عبد الناصر رحل في 28 أيلول /سبتمبر 1970، وهو يوم الانفصال نفسه قبل تسع سنوات.
رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبت، تتبدى الوحدة في الذاكرة العامة كحلم يستعصي على محاولات الإجهاز عليه. قالوا إن الوحدة «وهم ناصري»، وإن مصر فرعونية، أو شرق أوسطية، أو أي شيء آخر غير أن تكون عربية، لكن الحقائق تغلب باستمرار. فـ«مصر» ــــ بالثقافة والهوية والجغرافيا والتاريخ ــــ مشدودة إلى محيطها العربي، المصائر مشتركة، والقضايا واحدة. وعندما تنكّرت مصر لأدوارها، جرى ما جرى لها من تهميش وتراجع في المكانة.
يستلفت الانتباه في أداء عبد الناصر لحظة الانفصال مدى إدراكه للحقائق في سوريا وخشيته على مستقبلها. بعد الانفصال بأسبوع، قال في خطاب بثته الإذاعة المصرية، كأنه يقرأ طالع أيام لم تأتِ بعد: «إن الوحدة الوطنية في الوطن السوري تحتل المكانة الأولى... إن قوة سوريا قوة للأمة العربية، وعزة سوريا عزة للمستقبل العربي، والوحدة الوطنية في سوريا دعامة للوحدة العربية وأسبابها الحقيقية»، «لست أريد أن أقيم حصارًا سياسيًا أو دبلوماسيًا من حول سوريا، فإن الشعب السوري في النهاية سوف يكون هو الذي يعاني من هذا الحصار القاسي». وكان مما قال في ظروف الانفصال: «ليس مهمًا أن تبقى الوحدة، المهم أن تبقى سوريا». في لحظة الانكسار، تبدّت سلامة الرؤية.
أوقف التدخل العسكري المصري بعدما أرسلت قوات إلى اللاذقية خشية إراقة الدماء. كان ذلك إجراء سليمًا، رغم صعوبته، فلا وحدة تتأسس على إراقة دماء.
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قال محمد حسنين هيكل كأنه يقرأ كتابًا مفتوحًا في محاضرة ألقيت بالعاصمة الفرنسية باريس: «المشرق العربي هو الإقليم الذي أشعر بالخطر الشديد عليه، وأخشى أنه الآن مفتوح لخريطة جديدة ترسم له استعدادًا للقرن الحادي والعشرين، وفي الأغلب قبل انقضاء الربع الأول من ذلك القرن». الكلام بنصه هو ما يحدث فعلًا ومصائر المشرق العربي على حد السكين قبل أن ينتهي الربع الأول من هذا القرن. استنادًا إلى توقعاته، فإن موقفه كان حاسمًا من الأزمة السورية منذ بدايتها. لم تكن القضية بشار الأسد ومستقبل نظامه بقدر ما كانت سوريا ووجودها. المعنى نفسه هو صلب التضامن الشعبي المصري مع السوريين ضد محاولات التحريض عليهم، كأنه استدعاء جديد لبديهيات الأمن القومي والمصير العربي المشترك.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2019/06/20