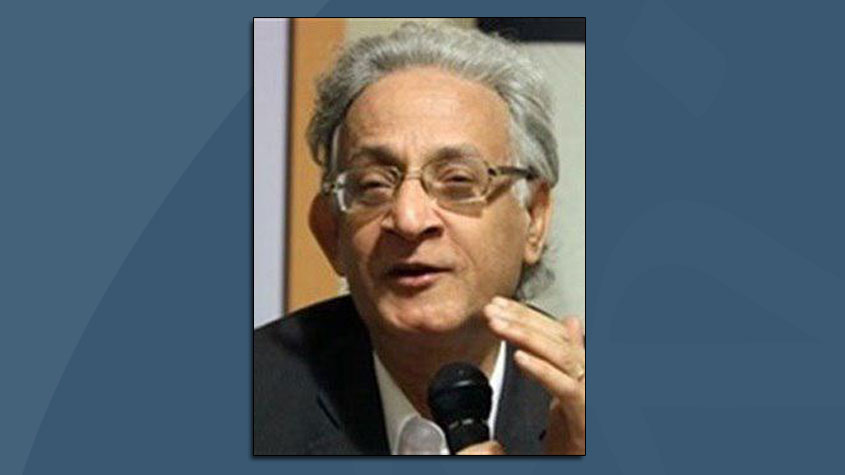حالة حرب معلنة

عبدالله السناوي
هذه حالة حرب معلنة بلا حشود عسكرية أو حركة دبابات. لا القانون الدولي يبيح إجراءاتها، ولا القواعد الدبلوماسية تبررها. كل شيء مستباح وكل حق مهدر. تركيع الفلسطينيين بالضغطين السياسي والاقتصادي هدف أول، وفرض «صفقة القرن» بلا شريك فلسطيني، أو جلوس إلى مائدة تفاوض وفق أية مرجعيات هدفٌ ثانٍ.هكذا تبدو الصورة من قصف سياسي إلى آخر، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، إلى إغلاق مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ومن قصف اقتصادي إلى آخر: من إحكام الحصار على غزة والسلطة الفلسطينية إلى وقف تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) التي تقدّم الخدمات الصحيّة والتعليمية لمن عانوا ويعانون شظف الحياة في مخيمات اللجوء.
تستند الحرب المعلنة إلى ما يسميه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سلام القوة. التعبير نفسه إعلان حرب. وتعمل خطتها على خلق الحقائق على الأرض والاستثمار السياسي في شبه انهيار العالم العربي الذي ترك الفلسطينيين وحدهم تقريباً يواجهون أشرس حرب يتعرضون لها منذ نكبة 1948.
كل خطوة في الحرب مقصودة، وتمهّد لما بعدها، والفصل بينها خطأ فادح في تقدير الموقف وتبعاته وتداعياته. كان نقل السفارة أخطر ضربة لمفاهيم التسوية التقليدية التي تركت مصير القدس لمفاوضات الحل النهائي تحت الرعاية الأميركية. تقوّضت المرجعيات والقرارات الدولية كأنها حبر على ورق. لم يكن رد الفعل في العالمين العربي والإسلامي ذا شأن في ردع ذلك العدوان على أبسط قواعد القانون الدولي، ولا مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دان نقل السفارة إلى القدس المحتلة حاجزاً دون مزيد من التغول الأميركي على ما تبقى من حقوق فلسطينية. إنّه التماهي مع المشروع الصهيوني في أكثر صياغاته عنصرية وتشدداً.
طلبت الإدارة الأميركية التسليم بـ«صفقة القرن» من دون أن تعلن بنودها، وما تسرب كان كافياً لتعبئة الرأي العام الفلسطيني ضدها. لم يكن بوسع أي طرف فلسطيني أن يوافق على التنازل عن القدس، أو يقبل ضم الكتل الاستيطانية في الضفة المحتلة إلى الدولة العبرية، أو التخلي عن حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإلا فإنها «الخيانة»، بتعبير محمود عباس رئيس السلطة، الذي لا يمكن وصفه بالتشدد!
من ناحية واقعية، ماتت «صفقة القرن» إكلينيكياً، فلا صفقة ممكنة إذا لم يتوافر لها شريك فلسطيني ويرفضها أصحاب القضية كلهم. ومن ناحية واقعية ثانية، يجري العمل على تنفيذها على الأرض بغض النظر عن وجود الشريك ومستوى الرفض. ومن ناحية واقعية ثالثة، فإن الدول العربية التي أبدت استعداداً معلناً للدخول في عمليات تطبيع اقتصادية واستخباراتية وعسكرية مع إسرائيل، من دون أي التزام بالمبادرة العربية التي تنص على التطبيع الشامل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام (1967) شبه توقفت، عن مثل هذا الانخراط خشية تداعياته على شرعية نظمها. لا يوجد غطاء سياسي أو أخلاقي بأي درجة يسوغ التسليم للإسرائيليين بكل شيء وحرمان الفلسطينيين أي شيء يستحقونه وفق القانون الدولي. ما بين الجموح الأميركي والممانعة الفلسطينية يبدو العجز العربي فادحاً. في الحرب المعلنة، هناك إجراءات يمكن التغلب عليها بصورة أو أخرى، مثل وقف حصة الولايات المتحدة في «الأونروا» التي تبلغ 370 مليون دولار، فقد عرضت دول أوروبية، مثل ألمانيا، زيادة حصتها، كما يمكن أي دولة نفطية أن تسد العجز المالي.
الأوروبيون يخشون التبعات الأمنية للخنق الاقتصادي لملايين اللاجئين. والدول العربية تبحث عن إبراء ذمة من دون صدام مع الإدارة الأميركية.
هناك إجراءات ذات طابع رمزي مثل إغلاق مكتب «منظمة التحرير» في واشنطن، إذ إن الاتصالات مجمدة بين السلطة والإدارة الأميركية على خلفية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والتلويح بالانقلاب على رئيسها محمود عباس. الأخطر ما يستهدف تنفيذه على الأرض بقوة الأمر الواقع. وقف تمويل «الأونروا» ليس هدفاً بذاته، بقدر ما هو تمهيد بالنيران لإلغاء قضية اللاجئين وحق العودة.
بعد 70 سنة من النكبة، يراد نسف البنية القانونية التي تثبت الحق الفلسطيني لشعب شرد بالسلاح والترويع خارج أرضه ومن حقه العودة إليها، وفق القرارين الدوليين 194 لسنة 1948، و513 لسنة 1952، أو الحصول على تعويض لمن لا يرغب في العودة. وفق أرقام الأمم المتحدة فإن أعداد اللاجئين المسجلة تتجاوز خمسة ملايين، فضلاً عن أعداد كبيرة أخرى هاجرت إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا وأميركا اللاتينية وغيرها، وأغلبهم حصلوا على تعليم متقدم. ووفق التقدير الإسرائيلي، الذي تتبناه الإدارة الأميركية، فإن أعدادهم لا تتجاوز نصف مليون.
من هو اللاجئ؟
الذي أجبر مع أسرته على مغادرة بيته وأرضه والحق ينسحب على أولاده وأحفاده، أو الطاعنين في السن وحدهم الذين عاصروا النكبة؟ لا توجد سويّة إنسانية تقبل مثل هذا التنكيل، فيما يصدر قانون في التوقيت نفسه عن الكنيست الإسرائيلي يعلن «قومية الدولة»، ويضفي أحقية اكتساب جنسيتها لأي يهودي في العالم من دون أن يكون ولد فيها أو عاش يوماً واحداً.
تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، التي توعّد فيها «المحكمة الجنائية الدولية» بملاحقة قضاتها والمدعين العامين فيها في حال استهدفت جرائم الحرب التي ارتكبتها بلاده في أفغانستان، أو الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية في فلسطين، تدعو إلى السؤال عما يمكن أن يجرّه أمراء الظلام الذين يحكمون البيت الأبيض الآن من أزمات وحروب على العالم كله، وليس الفلسطينيين وحدهم. كيف يمكن أن تمضي الحوادث في هذا النوع من سلام القوة؟
التصعيد مؤكد ومن بين أسبابه قرب انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونغرس» الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ترامب المأزوم يسعى إلى تصويت قاعدته الانتخابية المتعصبة لحزبه الجمهوري حتى لا يختل الميزان في الكونغرس ويجد نفسه تحت إجراءات العزل من منصبه.
لكن ماذا بعد الانتخابات الأميركية؟
الطرق مغلقة مهما تصاعدت الضغوط والإجراءات وشدة القصف. حلّ الدولتين مستبعد تماماً بالنظر إلى الاستهتار بأي مرجعيات دولية، فضلاً عن غياب أي شريك فلسطيني. وحل الدولة الواحدة مستبعد كلياً، فلا يعقل أن يوافق غلاة العنصريين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية على دولة لكل مواطنيها تعلي حقوق المواطنة للعرب واليهود على السواء. هذا وهم كامل. كما أن إقصاء الفلسطينيين بكتلتهم السكانية الكبيرة في فلسطين التاريخية - الضفة الغربية وغزة وداخل الخط الأخضر - وهم كامل آخر.
الحقائق الديموغرافية بكل حمولاتها السياسية والإنسانية لها كلمة أخيرة في أي حسابات مستقبلية أياً كانت غطرسة القوة. لا الترحيل الجماعي ممكن ولا العنصرية المفرطة تؤسس لأوضاع مستقرة. في نهاية الحرب، سوف تجد إسرائيل نفسها في مأزق لا مخرج منه، حيث الكتلة البشرية الفلسطينية. أفضل خيار سياسي ممكن التقدم إلى المصالحة الفلسطينية بوصفها مسألة حياة أو موت لا تحتمل الإرجاء، وإعادة بناء «منظمة التحرير» ممثلة عن وحدة الشعب والقضية، وحل السلطة حتى يمكن طرح القضية على وجهها الصحيح: سلطة احتلال، وشعب يقاوم.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2018/09/13