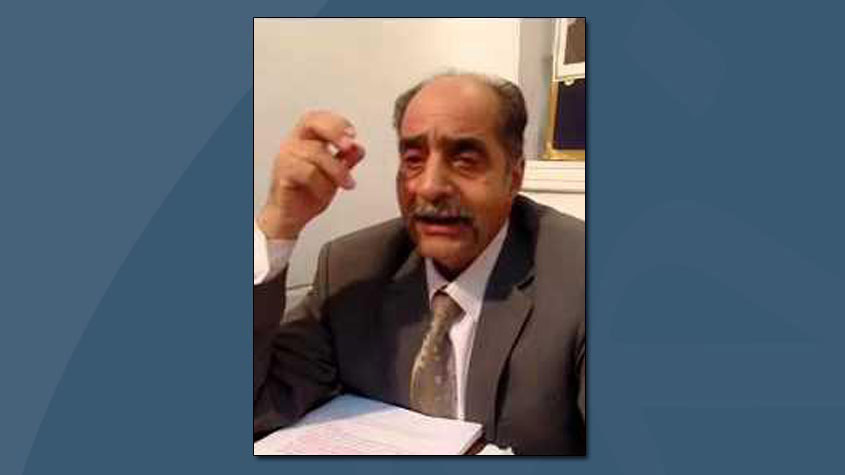بين العسكريين و«الليبراليين الجُدُد»: أضواء على «الحلقة المفرغة» للسلطة السياسية في الدول العربية [1]

محمد عبد الشفيع عيسى
الجيوش والسياسة، نظرة في ظرف الزمان والمكان
وجدنا من خلال إمعان النظر في الأحوال العربية الراهنة، ومنها الحالة المصرية، أن بلدان العالم العربي والإسلامي، من المنظور التاريخي، قد بقيت تسبح في بحر هائج مختلط الأمواج، من القديم والجديد طوال مئات السنين. وإن اقتصرنا على نصف القرن الأخير، أو أقل قليلاً، فإننا نجد أن هياكلنا الاجتماعية، ومن ثم السياسية، امتلكت السيادة فيها خلائط متنوعة من شرائح مختلفة. ومنها الشرائح ذات النفوذ في ممارسة السيطرة الثقافية و«القهر التراثي» إن صح التعبير، فيما يسمّى بالإسلام السياسي أو الحركي من دون أن يتحقق، بالطبع، المقابل المكافئ للإصلاح الديني الذي تمّ في الغرب في مطلع العصر الحديث- مع التسليم بنقائصه الجوهرية. كذلك نشير إلى الشرائح ذات النفوذ في مجال ممارسة العنف المجسد والعنف «المشروع» باسم الدولة، امتداداً لميراث «أسلوب الإنتاج الآسيوي» في الشرق، مقابلاً للإقطاعية في أوروبا الغربية بالذات. وهنا برزت فئة العسكريين، ذات النفوذ المتوارَث الطويل عبر أكثر من خمسمئة عام، تحت وطأة التحديات الخارجية، وثقل الحماية المفروضة من قِبل الوجود التركي مقابل التسلّط الغربي المتّجه نحو «تحويل المستعمرات» كولونياليّاً أي وفق صيغة «تقسيم العمل الإنتاجي» الاستعمارية: حيث تتخصص الدول المسيطرة في الصناعة الأعلى تطوراً، بينما تتخصص البلاد المتخلفة والنامية في المواد الخام والصناعات الأقل تطوراً.
كما تبرز ضمن معادلة السلطة، شريحة «أهل الحكم» الذين هم في الحقيقة يُعتبرون ممثلين أو وكلاء فعليين عن النتوء الطبقي السائد في كلّ مرحلة. فماذا عن العسكريين في البلدان العربية ودورهم في السلطة السياسية؟
من الصعب التحدّث هنا عن طيف واحد ليس غيره من أطياف النخب العسكرية أو ذات الجذور العسكرية في البلدان العربية. لنذكر في البداية أنّ هناك من قاد مشروعاً وطنياً-قومياً تقدّمياً، ومثاله جمال عبد الناصر.
والحق عندنا أن قيادة جمال عبد الناصر تمثّل نموذجاً فذّاً لتحوّل النخبة العسكرية، ذات الجذور الوطنية والأصول الاجتماعية الوسيطة، إلى نخبة سياسية ثورية، وطنية وقومية عروبية، تقدميّة المنحى الاجتماعي والمنهج الاقتصادي (التنمية والتصنيع) في إطار نزعة استقلالية أصيلة. كلّ ذلك رغم عدم القدرة على صياغة نسيج جديد للسلطة السياسية يرقى إلى مستوى التحوّلات الاجتماعية الكبرى التي تحقّقت بالفعل.
رغم الاستعانة بعنصر «الضباط الأحرار» وغيرهم من سلك الضباط العاملين في إدارة دولاب الحكم وتسيير مشروعات القطاع العام وخاصة بعد 1961، فضلاً عن الاستعانة بهم في السلك الدبلوماسي، إلا أنّ ذلك لم يكن يمثّل حُكْماً العسكريين بالمعنى الدقيق، نظراً إلى قوة شكيمة القيادة السياسية وسعيها الراسخ الدؤوب إلى إحداث التحوّل الاجتماعي وفق رؤية معيّنة.
قد حدثت تجاوزات (خطرة) في ثنايا قرارات التأميم لشركات القطاع الخاص وفرض ما سُمّي (الحراسة) على بعض الأفراد أو الجهات، وتولّي من هم أقل كفاءة مواقع لا يستحقونها، لمجرّد أنهم «أهل ثقة». بل لقد تجاوزت القوّات المسلحة دورها الخاص في الدفاع عن مصر والبلدان العربية، وخاصّة بعد حدث الانفصال (السوري) عام 1961، وجنحت القيادة العسكرية النافذة آنئذ، ممثَّلة بوزير الدفاع، خلال فترة السنوات الخمس 1962-67، وخاصة بين 1964-67، إلى تجاوز دورها، وقامت بوضع حاجز بين عبد الناصر والقاعدة الاجتماعية، فيما يشبه «الطبقة العازلة» وأقامت ما سُمّي في ما بعد بدولة «مراكز القوى»، مع انحراف أجهزة الأمن الخارجي عن دورها المرسوم. كلّ ذلك قد جرى كشفُه ومعالجته بطريقة معيّنة بعد الهزيمة من العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيو/ حزيران 1967.
رغم الثغرات، فقد كان دور العسكريين - مع التأكيد على التجاوز الخطير - مثالاً للاندراج العسكري في إطار مشروع وطني وقومي اجتماعي تقدّمي كبير. كانت فترة ثورة 23 يوليو/ تموز بهذه المثابة، منذ انبثاقها عام 1952 حتى وفاة عبد الناصر (28 سبتمبر 1970) استثناءً من ظاهرة الانقلابات العسكرية التي بدأت في البلدان العربية فى نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات (سامي الزعيم وأديب الشيشكلي في سوريا)، والتي تجسّدت في أنظمة استبدادية خالصة في لحظات معينة من تطوّر العديد من بلدان الوطن العربي، وكذلك في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية على وجه الإجمال.
تجاوزت القوات المسلحة دورها الخاص في الدفاع عن مصر والبلدان العربية
ذلك الاستثناء (اليوليويّ) – إن صحّ التعبير – وما يناظره في بلدان أخرى من القارات الثلاث بدرجات متفاوتة، يثبت القاعدة العامة القائلة بجنوح النخب العسكرية الخالصة إلى الاندراج في سلك أنظمة تسلطية ذات توجّه رجعي اجتماعياً، وتابع للغرب وقيادته الأميركية على وجه العموم.
يصدق ذلك على الحالة المصرية في المرحلة ما بعد وفاة عبد الناصر (1971)، حيث قام أنور السادات ببناء نظام تسلطيّ اندمجت من خلاله قيادته السياسة ذات الجذور العسكرية بتشكيلة اجتماعية موالية للقوى الطبقية الجديدة، التي استفادت من السياسة المسماة بالانفتاح الاقتصادي، ومن التبعية للغرب وأميركا، والخضوع لبعض الإملاءات الإسرائيلية بمقتضى «الصلح المنفرد». وعلى هذا النهج سار النظام المباركي طيلة ثلاثين عاماً (1981-2011) وإن اختلف الشكل الذي اندرج فيه العنصر العسكري في بنية النظام السياسي، فقد حدث ما يشبه «البناء الموازي» للسلك العسكري مقابل سلك الأمن الداخلي (المتواطئ) مع القيادة السياسية العليا، وخاصة في فترة التجهيز لمشروع «الوريث» خلال العقد السابق على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وخلال «ثورة يناير» وقفت القوات المسلحة في غير تعارض مع المطلب العام للقوى الاجتماعية الغالبة، ومارست دورها السياسي بشكل مباشر حتى إجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية (2011-2012)، ثم أخذت تمارس دورها ذاك بصورة أو بأخرى.
الجيش والسياسة عندنا وعند غيرنا
لم يكن الدور السياسي الحاكم، أو الحاسم، عندنا، وقفاً علينا، فقد أدّت الظروف التاريخية للقارات الثلاث في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى خضوعها لمسار مختلف عن أوروبا، والغرب عموماً؛ لا بل كانت وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية بمثابة «مقلوب» الوضعية الأوروبية بالذات، بحكم إخضاعها للاستعمار الأوروبي بالذات. وذلك حديث يطول.
المهم أنه في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي (أو ما بعد الاستعمار) post colonialism أدت الجيوش الوطنية الجديدة، في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، دوراً محورياً في السياسة المحلّية والعلاقات الخارجية للبلدان الناشئة المستقلّة بعد رحيل الاستعمار القديم، خاصة البريطاني والفرنسي، بوجهه العسكري والسياسي السافر. وُجدت في هذا المضمار عدة حالات متنوعة، ولكن النتيجة مشتركة: في الحالة الأولى كان الاستعمار يؤسّس لأجهزة عسكرية للمساعدة في حفظ الأمن داخل المستعمرات؛ وحينما تم الاستقلال بقيادات وطنية متنوعة المشارب، فإنّ هذه القيادات في سعيها لإقامة أركان الدولة الجديدة لم تجدْ بُدّاً من الاعتماد على البناء العسكري القديم وإعادة تكييفه مع الوظيفة الجديدة. كان الجيش المعاد بناؤه على هذا النحو هو أقوى الهياكل الموروثة من العهد الاستعماري، إلى جانب جهاز إداري صغير محدود الكفاءة، مصمّم في الأصل لتسيير أمور المستعمرات. كانت هذه هي حالة معظم الدول الأفريقية جنوب الصحراء، بصفة خاصة، والعديد من الدول الآسيوية. أما بلدان أميركا اللاتينية الحاصلة على استقلالاتها عموماً خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر فقد كانت لديها بُنى عسكرية مستقرة نسبياً، كوريثة لقوى المقاومة على النموذج البوليفاري ضد الاستعمار الإسباني والبرتغالي. وهذه هي الحالة الثانية في مضمار العلاقة بين الجيوش والسياسة.
حدث ما يشبه «البناء الموازي» للسلك العسكري مقابل سلك الأمن الداخلي (المتواطئ) مع القيادة السياسية العليا
أمّا الحالة الثالثة فهي التي كان الجيش فيها بعد الاستقلال هو نفسه قوّة المقاومة الوطنية المسلّحة ضد الاستعمار وقد أعيد بناؤها. هذا ما حدث في الجزائر حيث «جيش التحرير الوطني» سليل قوات «جبهة التحرير الوطني» التي خاضت الحرب التحريرية المسلحة طوال ثماني سنوات تقريباً (فاتح نوفمبر/ تشرين الثاني 1954- الرابع من يوليو/ تموز 1962)، قدّمت خلالها نحو مليون ونصف المليون شهيد. وحدث مثل ذلك في فيتنام أيضاً.
وإذا كانت الجزائر وفيتنام تقدّمان الحالة «النقية» للجيش الوطني الذي هو جيش المقاومة السابق، فإن هناك حالات مختلطة كانت القوات المسلحة فيها بعد الاستقلال وريثة مزيج من قوى الأمن في العهد الاستعماري ومن قوى المقاومة. وكان هذا المزيج مختلف النسب بين دولة وأخرى، فحيناً يتغلّب عنصر الأخذ عن العهد الاستعماري، وحيناً آخر يتغلب عنصر الأخذ عن قوى المقاومة، وتلك حالة العديد من الدول الآسيوية، مثل أندونيسيا وماليزيا.
تبقى الجيوش في الدول العربية ممثلة للأطياف السابقة جميعاً: فالجيش المصري الحديث مزيج من البناء المركّب للجنود والضباط من الفلاحين – ورثة أحمد عرابي – ومن شرائح وسطى على غرار (دفعة جمال عبد الناصر) في الكلية الحربية وما يتزامن معها تقريباً منذ أواخر الثلاثينات من القرن العشرين...
بالإضافة إلى أثر التكوين الاستعماري البريطاني للجيش كأداة معاونة في معارك بريطانيا إبان الحربين العالميتين: الأولى (1914-19) والثانية (1939-45)، وكأداة معاونة للإنكليز في السيطرة على السودان لصالح بريطانيا بمقتضى ما سُمّي «باتفاقية الحكم الثنائي» لعام 1899. بعد ثورة 23 يوليو / تموز 1952 واستقلال السودان عن مصر رسمياً عام 1956 أعيد بناء الجيشين الوطنيين من العناصر التركيبية السابقة على نحو ما ذُكر.
وفي كلّ من هذين البلدين العربيين، كان الجيش هو أهمّ المؤسسات الوطنية الجديدة لما بعد الاستعمار، بل لعلّه ربما كان المؤسسة الوحيدة تقريباً بالمعنى الكامل للبناء المؤسسي، إلى جانب جهاز إداري محدود للإشراف على جباية الضرائب وحماية نهر النيل وضبط تدفّق المياه. من ثم كان للجيش في مصر والسودان دور كبير، تمثّل سودانياً في إقامة ديكتاتوريات متتابعة ذات عصب عسكري أساسي، يفصل فيما بينها حكم مدني بتكوينات مختلفة، طائفية أحياناً (المهدية والختمية) مع مشاركة ليبرالية أو شيوعية أحياناً أخرى.
إضافة إلى جيوش مصر والسودان والجزائر، كان هناك دور بارز للجيش العراقي، حيث تتشابه ظروف نشأته نسبياً مع الحالة المصرية، بفعل التماثل النسبي للظروف الاجتماعية والسياسية بحكم الانتماء إلى الوطن العربي الكبير، ثم بالنظر إلى وحدة المحتل البريطاني. كما كان للجيش دور ملحوظ في البنية المؤسسية لدولة المغرب الأقصى المخزنيّة، ذات الطابع التاريخي التليد.
فيما عدا ذلك، لا نلحظ وجوداً مؤسسياً مهيمناً للجيوش في بلدان عربية متنوعة مثل تونس ولبنان والبلدان الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي».
لا غرْوَ إذن أن نجد للعسكريين دوراً جلياً في السياسة العربية في مختلف الأقطار العربية، ولا غرابة أن يكون للعسكر أدوار متعددة قوية في عملية الحكم، وأن يتناوبوا على السلطة مع النخب المدنية، ويعودون دائماً في لعبة كرّ وفرّ دائرية دائبة. هذا جزء لا يتجزّأ من الدائرة المفرغة للعبة السلطة في البلدان العربية – المعاصرة، أو للدائرة المفرغة. فماذا عن بقية أجزاء «الدائرة المفرغة» للسلطة في البلدان العربية، وخاصة «نخبة السلطة»؟
صحيفة الاخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2019/06/26