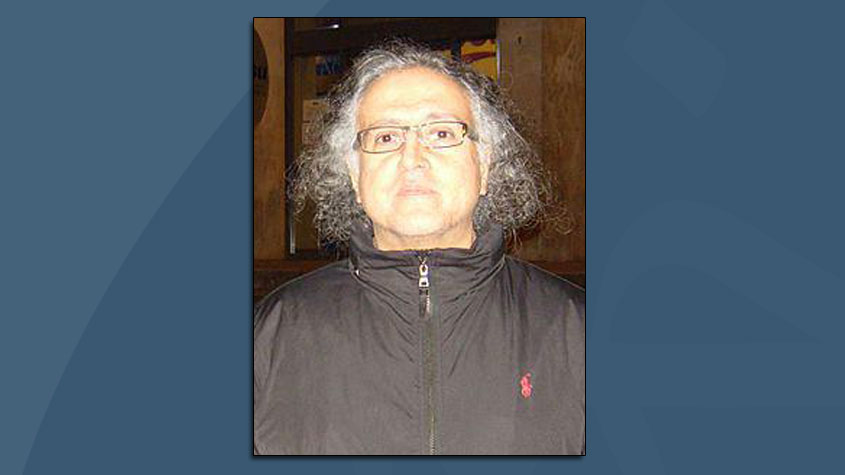أميركا ستهبّ لنجدة فاسدي لبنان: إنقاذُ النظام
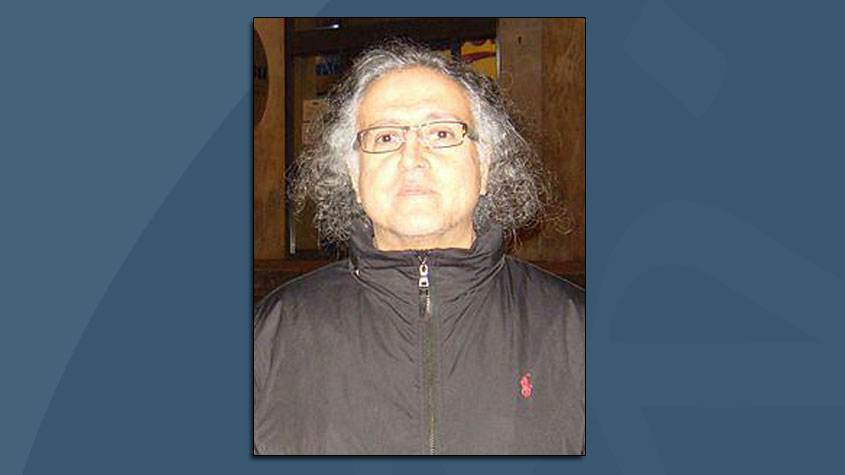
أسعد أبو خليل
سُرَّ بعض اللبنانيّين بمشهد الإعلامية الدعائية (الصهيونية حكماً)، هادلي غامبِل، وهي تُمطر جبران باسيل بوابلٍ من الاتّهامات والأسئلة. ثم زادت عليها باستفتاء جمهور الجلسة (في مدينة «دافوس» الثورية الجماهيرية) على أدائه، لكأن النائب في لبنان مسؤول، ليس أمام الشعب اللبناني، بل أمام جمهور «دافوس». والطريف في الموضوع أن بعض من يصيحون بهتاف الثورة (أو «ثاو، ثاو، ثورة») في لبنان، سطّر رسائل استجداء وإلحاح على القيّمين في «دافوس»، من أجل منع ظهور باسيل، بينما مرور مجرمي حرب صهاينة وفاسدين من لبنان والعالم العربي في دافوس، على مرّ السنوات، لم يستفز هؤلاء الثوار. لكنّ ظهور باسيل ــ على سوئه وعنصريته وعدم كنّه عداءً لإسرائيل ــ استفزّهم. أمّا الطلب من «دافوس» تفهّم مشاعر «ثوّار» في لبنان، فيخفي جهلاً أو عدم اكتراث بدور «دافوس» في الترويج لوصفات المصارف العالمية الكبرى، وصندوق النقد، والبنك الدولي، أي الترويج لتلك البرامج التي قادت لبنان إلى الكارثة. والإعلامية المُقيمة في الإمارات (والمعروفة بتطبيلها وتبجيلها لطغاة الخليج، على طريقة عوني الكعكي، لكن باللغة الإنكليزية) تعاملت مع المقابلة، على أنها مباراة ملاكمة حكّمت فيها حكّام الخليج ومصارف الغرب والبنك الدولي. صفّق بعض ثوار لبنان لهذه الإعلامية، لأن تعاطف الرجل الأبيض مع قضايا بعض سكان المنطقة يُشعرهم بالأهمية. لبنان بلد قام مسؤولون فيه بمنح جون بولتون (الداعي للحروب ضد العرب والمسلمين والمعروف بتعصّبه ضد الإسلام والمسلمين)، درع ما يُسمَّى بـ«ثورة الأرز»: وهل قبّح تاريخ الثورات في العالم إلا إطلاق وزارة الخارجية الأميركية على همروجة رفيق الحريري، وصف «الثورة»؟
الحكومة الأميركية، كانت مُحكمة بإعلان موقف ما ضدّ مكافحة الفساد في لبنان. والفساد هو النافذة التي تمرّ من خلالها المؤامرات الأميركية السرية، والسياسات التي يصعبُ أن تصدر عن ممثّلي الشعب في بلد مثل لبنان، وله من الشكل الديموقراطي والتمثيل السياسي ما ليس للحلفاء الوثيقين لأميركا في بلادنا. الفساد هو المجال الذي يسمح لأميركا بالتعامل السهل مع حكومات، وفرض رؤى تخالف إرادة الشعوب. الفساد هو المجال الحيوي للسياسات الغربية، لأنه يمنحها ما لا تستطيع الديموقراطية أن تمنحها إياه. خذوا حالة فلسطين، حيث طالبت إدارة جورج بوش، وسمحت، بإجراء انتخابات، في عام ٢٠٠٦، فقط لأنها عوّلت على تمويلها ودعمها لحركة «فتح». وعندما جاءت النتائج مُخيّبة للسياسة الأميركية، انقلبت الإدارة على النتائج وشاركت في مؤامرة دحلانيّة لقلب الحكم المنتخب ديموقراطياً، فقط لأنّ أعوان أميركا في «فتح» فشلوا. أي أن أميركا تختار الفساد الفتحاوي العريق على نتائج انتخابات ديموقراطية. والأمر نفسه في لبنان. كان النظام اللبناني الرئاسي الاستبدادي، خير نظام لدول الغرب كي تستعمل الساحة اللبنانية لضرب الاتحاد السوفياتي ومصالحه، ولضرب قوى القومية العربية واليسار (لم يكن هناك اختيار في النظام السياسي اللبناني قبل الحرب، إلّا في قدرة النواب على اختيار رئيس بين عدد قليل من المرشّحين: وكل الانتخابات الأخرى كانت فروعاً للصراع بين زعماء موارنة نافذين).
أما قانون السرية المصرفية، فقد كان حاجة ضرورية لحكومات الغرب، لأنها كانت تضخّ أموالاً طائلة في المصارف اللبنانية، لتمويل عمليات استخبارية وإرهابية غربية ضدّ أعداء أميركا وإسرائيل، كما أن القانون غطّى على عمليات الإنفاق التي كانت حكومات الخليج تقوم بها، لدعم حلفاء أميركا وإسرائيل في لبنان، بينما خلق أيضاً تعدّد الصحف ذات الولاءات الخارجية في لبنان. قانون السرية المصرفية، هو تعطيل للانتخابات في بلد عربي مثل لبنان، حيث يمكن للشعب أن ينتخب ممثلّين عنه (ضمن شروط القوانين الانتخابية المُقيِّدة للحرية الديموقراطية)، ومن دون ضوابط حقيقية فعلية على الإنفاق الانتخابي. هذا تماماً ما تريده أميركا. إنّ حرية الإنفاق الانتخابي، تسمح لأميركا (وللدول الغربية ودول الخليج) التأثير في نتائج الانتخابات لصالح مرشحين يأتمرون بإمرتها. لم تكن انتخابات الرئاسة في تونس، في عام ٢٠١٤، تعبيراً عن إرادة الشعب التونسي، بقدر ما كانت تعبيراً عن إنفاق دول الخليج والغرب لصالح الباجي قائد السبسي. ويمكن اعتبار كلّ الانتخابات النيابية في لبنان، متأثّرة بالتمويل الغربي (والعربي والإيراني في بعض الأحيان). لكن الانتخابات النيابية، منذ عام ٢٠٠٥، كانت، في حسم نتائجها لصالح ١٤ آذار، تعبيراً عن الإغداق المالي الغربي والخليجي. حتى الإعلام الغربي، لاحظ حجم الإنفاق الغربي ــ الخليجي في انتخابات ٢٠٠٩ (قلّ أو اضمحلّ التمويل الخارجي في الانتخابات الأخيرة. ففازت قوى ٨ آذار). وكتاب «حبال من رمال» لعميل الاستخبارات الأميركية، ويلبور إيفلاند، الذي صدر قبل ٤٠ سنة، يفصّل حمل حقائب المال الأميركي لكميل شمعون في الخمسينيّات.
الفساد، هو الذي يسمح لأميركا بالتأثير المباشر في الأنظمة الاستبدادية، عبر رعاية الطغاة الفاسدين، وعبر دعم اختيارات أميركية بالمال (في بلد مثل لبنان). والملاحظ، أن مطالب المحتجّين والمحتجّات في لبنان لا تتّفق على الكثير، باستثناء طلب إجراء انتخابات نيابية فورية. وهو طلب غير مفهوم، لأنّ الطبقة الحاكمة تستطيع أن تجدّد لنفسها وأن تتأقلم مع أيّ نظام انتخابي كي تعود. ويمكن لتيّارات جديدة أن تحصل على مقعد أو معقديْن فقط، خصوصاً أن إجراء انتخابات على مستوى كلّ لبنان، يتطلّب تنظيماً على مستوى الوطن لا يتوفر إلا للأحزاب النافذة، كما ستعطي الانتخابات حظوة لمن يراكم أصواتاً على مستوى كلّ الوطن. لكنّ مطالب الحراك لا تتحدّث عن مكمن الفساد الكبير في انتخابات لبنان، أي الإنفاق الانتخابي.
أميركا تبسط نفوذها إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد
إنّ الإنفاق الانتخابي، هو الذي يسمح للزعماء بالاستفادة من ثروات طائلة، ومن تحالفات مع أثرياء، كما أنّ معظمهم (خصوصاً في المحور السعودي ــ الأميركي) يتمتّع بالدعم المالي الغربي الذي لم يتوقّف عن التدخّل في الانتخابات النيابية اللبنانية، منذ الاستقلال. ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة، بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان. لكنّ أميركا، وهي أكثر الدول تدخلاً في العالم العربي، وإن كان شعار «لا أميركا، ولا إيران» يحاول أن يخفّف من حجم تدخلها، ستقاوم سنّ قانون انتخابي يعطّل الفساد الذي تنفذ منه.
جيفري فيلتمان تقاعد من الإدارة الأميركية، بعدما كان له دور رئيس في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بالتنسيق والتعاون مع اللوبي الإسرائيلي. ليس فيلتمان من صنف المستعربين، الذين يعرفون ثقافة ولغة وتاريخ العالم العربي (في كلّ سنواته لم يستعمل إلا كلمة «شكراً»، وكانت تصدر عنه بلفظ مبتكر). هو من الصنف الجديد في عملية صنع السياسة الخارجية في الشرق الأوسط: لم تعد المعايير تعتمد على التخصّص، بقدر اعتمادها القدرة على التعبير والتصريح بأولويات وسياسات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. كما أنّ المعيار يعتمد على القدرة على السيطرة على أدوات أميركا في المنطقة، وقد أحسن فيلتمان إدارة وتسيير أمر فريق ١٤ آذار في لبنان، فحُسبت هذه له من قِبل اللوبي الإسرائيلي. هناك من حاول، أخيراً، أن يعِظ بشأن دور فيلتمان، مثل ساطع نور الدين، الخبير الجديد والفريد في السياسة الخارجية الأميركية، والذي أعلن قبل شهر من ظهور جاريد كوشنر على كل الشاشات العالمية، لإطلاق «صفقة القرن» التي أعدّها ويروّج لها، أنّ ترامب أقصى كوشنر عن كلّ ملفات السياسة الخارجية (وهذه المعلومة هي حصرية لساطع نور الدين). قال البعض إن فيلتمان تقاعد، ولم يعُد له دور في الإدارة.
لكن المُتقاعد في الإدارة الأميركية، وخصوصاً بمستوى فيلتمان ومركزيّة دوره في اللوبي الصهيوني على مرّ سنوات طويلة، يبقى نافذاً في العاصمة، ليس فقط بحكم موقعه في مراكز الأبحاث والإعلام الأميركي، بل أيضاً في الكونغرس الأميركي. عندما حضر فيلتمان جلسة استماع في الكونغرس، كان يعطي نصحاً لساسة يثقون في منطلقات توجّهاته وصهيونيّته. والنافذون في الإدارة، يعقدون جلسات سرّية في مختلف وزارات ووكالات السلطة التنفيذية، يدعون إليها مسؤولين سابقين مثل فيلتمان. وعليه، فإنّ فيلتمان يظلّ، مؤثّراً بدرجة، في ما يحصل في داخل الإدارة. وينسى هؤلاء أن الإدارات الأميركية، في البيت الأبيض تحديداً، تدعو مسؤولين أميركيّين متقاعدين خبراء في مناطق مختلفة في العالم، إلى جلسات واجتماعات مُغلقة. فعندما واجه جيمي كارتر أزمة الرهائن، دعا مستشاره للأمن القومي مسؤولين خبراء متقاعدين، مطّلعين أو متخصّصين في الشأن الإيراني، من قطاعات مختلفة في الحكومة الأميركية.
لكن توقيت تقرير جيفري فيلتمان، في موقع «مؤسّسة بروكينغز» (يُعدّ مركز الأبحاث هذا قريباً من الحزب الديموقراطي، ويمكن تصنيف مراكز الأبحاث في واشنطن بناء على قربها أو بعدها ــ تمويلاً ــ من أنظمة الخليج، إذ إن معظمها مُموّل من النظام السعودي أو الإماراتي أو كليهما، فيما يستفيد «بروكينغز» من تمويل قطري، كما أن قطر تستضيف فرعاً للمؤسّسة التي يدير عملها الشرق أوسطي، مارتن أنديك، خرّيج اللوبي الصهيوني ومؤسّس الذراع الفكرية له، أي «مؤسّسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»). عبّر التقرير عن هلع ممّا يمكن أن تصيبه حملة مكافحة الفساد من أعوان وأدوات واشنطن في لبنان. وهنا الدور الذي يلعبه ــ وفق خطة مرسومة ــ مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية، لأنّه يمكن لهم التعبير عن مخاوف وقلق يصعب على مسؤولين سابقين التعبير عنه. يسمّي فيلتمان بالاسم أشخاصاً محدّدين، ويتوقّع أن تؤدّي حملة مكافحة الفساد ضمن الحكومة الحالية، إلى النيل من أعداء حزب الله في لبنان. بهذه الصراحة، عبّر فيلتمان عن نفسه (وعن غيره).
وقال إن الحملة التي ستقوم بها حكومة حسّان دياب، يمكن أن تؤذي فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد جنبلاط «وحلفائهم». وهذه التسمية تشرح الكثير عن أدوار هؤلاء الداخلية، بإيعاز من الخارج. أميركا تتخلّى عن حلفائها من دون ندم عندما تستنفدهم، وتدافع عنهم طالما هم مستعدّون وقادرون على خدمة مصالحها. وهذه التسمية هي نتاج مباحثات، لا بدّ أن تكون قد حدثت بين مسؤولين أميركيين (سابقين وحاليّين)، وبين أعوان أميركا الذين طلبوا منها حمايتهم من حملات مكافحة الفساد. وكما أنّ النظام السوري كان يحمي فاسديه في لبنان (الذين كانوا مرتبطين بفاسدين في داخل النظام السوري)، فإنّ الحكومة الأميركية هبّت اليوم لإعلان إطلاق عملية الدفاع عن فاسدين موالين لأميركا في لبنان. فيلتمان يكنّ ضغينة ضدّ ميشال عون، أفصح عنها في مقالته، عندما لامه لأنه شنّ «هجوماً على الفساد» بعد عودته إلى لبنان. قالها فيلتمان حرفيّاً، أي أنّ جريمة ميشال عون أنه أطلق حملة ضد الفساد بعد عودته، لأنّ ذلك يعني، بحسب فيلتمان، ملاحقة عائلة الحريري ووليد جنبلاط. ولا شكّ في أنّ فيلتمان عبّر، في المقالة، عن حالة من الذعر تسود بين فاسدي أميركا في لبنان. مشهد طرد السنيورة من الجامعة الأميركية، يُعدّ إهانة شخصية لجورج بوش، راعي السنيورة الأوّل.
وفي حديثنا عن فيلتمان، لا يجب أن نزيل من الحسبان عامل الفساد عند المسؤولين الأميركيين السابقين، إذ يحكم أداء هؤلاء في سنوات الخدمة، نظرتهم إلى مستقبلهم في الـ«بزنس» بعد تقاعدهم. أستطيع أن أقول إن كلّ سفير أميركي في السعودية (باستنثاء هيوم هوران، الذي طرده الملك فهد من المملكة لأنه، وهو الضليع بالعربية، كان يخوض نقاشات مع رجال دين)، ارتبط بعلاقات مالية مع أمراء سعوديين. تحادثتُ مطوّلاً عن السعودية مع السفير الأميركي السابق، تشالز فريمان (المكروه من قبل اللوبي الصهيوني) وسألته إذا ارتبط هو الآخر بعلاقات ماليّة، فأجابني بالإيجاب. خذوا وخذنَ السفير السابق في بلادنا والمسؤول عن الشرق الأوسط في إدارة رونالد ريغان، ريتشارد مورفي (آخر المُستعربين): لم يصبح مستشاراً لرفيق الحريري والنظام السعودي بعد تقاعده، بل إنّ زوجته أيضاً عملت في مؤسسة الحريري في واشنطن. هذا فساد قانوني في أميركا. تقرأ وثائق «ويكليكس»، وترى كم كان فيلتمان هذا مبهوراً بثروات فاسدي لبنان. في لقاء بين سفير أميركي وبين نجيب ميقاتي، تجد جيفري فيلتمان مبهوراً بثروة ميقاتي يسأله بالتفصيل عن مكان إقامته في مونت كارلو، وإذا كان قد ابتاع لنفسه منزلاً هناك. لو فتّشنا في الحسابات المالية لفيلتمان، لا أستبعد أن يكون مرتبطاً مالياً بعدد من فاسدي لبنان.
ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان
وبلغت الوقاحة الخاصّة بفيلتمان، أنه شبّه حكومة «اللون الواحد» الحالية بحكومة يكرهها، ألا وهي حكومة عمر كرامي الأخيرة، لكأن هذه الحكومة سرقت ونهبت من الخزينة، كما فعلت حكومة أميركا الواحدة بقيادة الحريري أو السنيورة أو ميقاتي أو تمام سلام. فيلتمان لا ينصح بمقاطعة حكومة حسان دياب، لأنّه يحذّر من عواقب عزل السلطة، ما يُضعف المصالح الأميركية. وأشار تحديداً إلى المصالح الأميركية في منع السيطرة الروسيّة على ثلاثة موانئ شرق أوسطية، ومحاربة الإرهاب والطاقة. أي أن أميركا تريد حصّةً من الفساد اللبناني. وحذّر فيلتمان من قطع العلاقات بين الجيش اللبناني والحكومة الأميركية. كذلك، فضح فيلتمان الدافع الأميركي من وراء تمويل ومدّ الجيش بسلاح بدائي ضعيف: ليس الموضوع هو حماية لبنان، بل إن الجيش هو «الأداة الأفعل لتقويض سرديّة حزب الله الخبيثة عن حماية لبنان». يصرحّ فيلتمان، هنا، للشعب اللبناني بأنّ موضوع حماية لبنان، لا صلة له البتّة بالتسليح الأميركي، بل إنّ هذا التسليح هو عمل دعائي لإيهام الشعب اللبناني بأنّ هناك قوّة تستطيع أن تكون بديلة عن المقاومة (طبعاً، رأى الشعب اللبناني بأم العين أنّ الجيش المُجهَّز أميركياً وقف عاجزاً أمام هجمة «داعش» و«النصرة»، إلى أن أنقذه حزب الله، كما وقف عاجزاً أمام زعران «القوّات» في جلّ الديب). لا نحتاج إلى خبير أو مسؤول من مرتبة فيلتمان، كي يعترف لنا بأنّ التسليح الأميركي للجيش، لا علاقة له البتّة بالدفاع عن لبنان، لأنّ نوعيّة السلاح والمبالغة في تقدير ثمنه وقوته، أمر ظاهر بصورة مضحكة في الاحتفالات التي يعدّها قائد الجيش الحالي لوصول أي مساعدة أميركية، ولو كانت صندوقاً من المسدّسات أو الخرطوش.
ويعترف فيلتمان، أخيراً، بما اعترف به بخفر في جلسات الاستماع في الكونغرس، قبل أسابيع، أي أنّ الحكومة الأميركية لن تقطع مع الفاسدين في لبنان.
هو يقول: «نحن نتعامل مع أمراء حرب كثيرين في أفغانستان وأماكن أخرى»، أي أنّ القطع مع الفاسدين لا يمثّل السياسة الأميركية ولا يخدم مصالحها، وهو محقّ في ذلك، إذ لم يطب المقام لأميركا في احتلال بلادنا، من دون إنشاء طبقة من الفاسدين لخدمة مصالحها: من العراق إلى فلسطين إلى ليبيا، إلى عهد أمين الجميّل في لبنان. الاحتلال الخارجي يحتاج إلى طبقة فاسدين لخدمته، وهناك سبب آخر لهذا العامل: تختلف السياسة الأميركية عن السياسة السوفياتية في بلادنا في الحرب الباردة. في تلك الحقبة، كان الكثير من العرب مستعدّاً لأن يتطوّع لخدمة الاتحاد السوفياتي لأنه، بدرجة ما، حمل قضايا عربية حاربتها أميركا وإسرائيل. أما أميركا، فلو أنها دولة غير غنيّة، مثل كوبا أو فنزيلا اليوم، فإنها لن تجد موالين لها. المال والنفوذ السياسي (بالإضافة إلى القوّة الصلبة)، هي سلاح أميركا، والفساد حيوي وضروري للسماح لها ببسط السيطرة والنفوذ في منطقتنا. أميركا تبسط نفوذها، إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد، لأنّ هوّة تفصل بين المصالح الأميركية ــ الإسرائيلية، وبين تقدير المصلحة العربية من منظور الفرد العربي (لو أن للقراء العرب حقّ الاختيار، هل كان يمكن لهم مثلاً اختيار أبواق الطغاة كمعبّرين عن مشاعرهم وآمالهم؟).
ويختم الناصح فيلتمان تقريره، بالطلب من حكومة بلاده استغلال الوضع الاقتصادي الضاغط والبائس في لبنان. هذه هي أميركا: تجعل من مصائب الشعوب فرصاً للاستغلال والسيطرة والفساد، لها ولأعوانها. وهذا الاستغلال سيتّخذ شكل ربط المساعدات الاقتصادية بتقليص تمثيل الحزب في الحكومة، وحماية فاسدي أميركا من المحاسبة والمقاضاة. وهؤلاء الأثرياء الفاسدون يقدّمون خدمات شتّى للعمليات السرية للحكومة الأميركية (مثل الإنفاق على عمليات غير مشرّعة من الكونغرس، أو تحويل أموال، أو تمويل عصابات موالية لأميركا، إلخ). أميركا مُمسكة بخناق كل الأثرياء في العالم العربي، ولهذا كلّهم مطواعون خانعون لها، مثل أثرياء فلسطين الذين لا يدعمون الحركات المقاوِمة من أجل فلسطين. تستطيع حكومة أميركا، بقرار من وزارة الخزانة، تقويض ثروة ملياردير عبر فرض عقوبات، ومنعه من استخدام النظام المالي العالمي وتجميد أرصدته.
الخلاصة: تريدون مكافحة الفساد؟ غير ممكن من دون مكافحة السيطرة الأميركية ــ الإسرائيلية في بلادكم. لكنّ الموقف الأميركي سيكون: تريدون مساعدات وإخراج لبنان من الكارثة؟ هناك ثمن يجب تدفيعه لحزب الله وحليفه العوني. نشرت صحيفة «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء الماضي، مقابلة مع مَن وصفته برئيس حكومة لبناني سابق (أي السنيورة)، وفيها يوضح هذا النقي التقي الورع، أنّ الحكومة الأميركية ستشترط تغييراً في سلوك حزب الله في الداخل والخارج. ماذا يقصد حضرته الوثيق الصلة؟ تغيير السلوك، مثلاً، نحو إسرائيل والصهيونية، كي يوافق الحزب على استراتيجية الدموع والعويل التي انتهجها السنيورة بديلاً من المقاومة المسلّحة في حرب تمّوز؟ وهذا الرجل نفسه كان قد وعد أنه سيحرّر مزارع شبعا بـ«النضال الديبلوماسي»، وما زلنا ننتظر ثمار نضاله.
هناك صفقة ستجري في لبنان على حساب العدالة الاجتماعية. سيأتي الغرب إلى لبنان بصفقة مثل صفقة مورفي، في عام ١٩٥٨، عندما اتفقت الإدارة الأميركية وجمال عبد الناصر على تشريع فؤاد شهاب رئيساً توافقياً في لبنان. أميركا ستربط مساعداتها للبنان بحماية كلّ فاسديها (أي الأكثرية الساحقة من الطبقة الحاكمة في لبنان) مقابل مساعدات مشروطة. هي تريد النظام الذي خدمها منذ استقلاله، وهي ستحاول أن تحدّ من نفوذ حزب الله، وأن تفرض تغيير نهجه المقاوِم. لكن هيهاتِ.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2020/02/01