عودة عن خطأ السنوات المبكرة: لم يحتضن اليمن ملوك بني إسرائيل
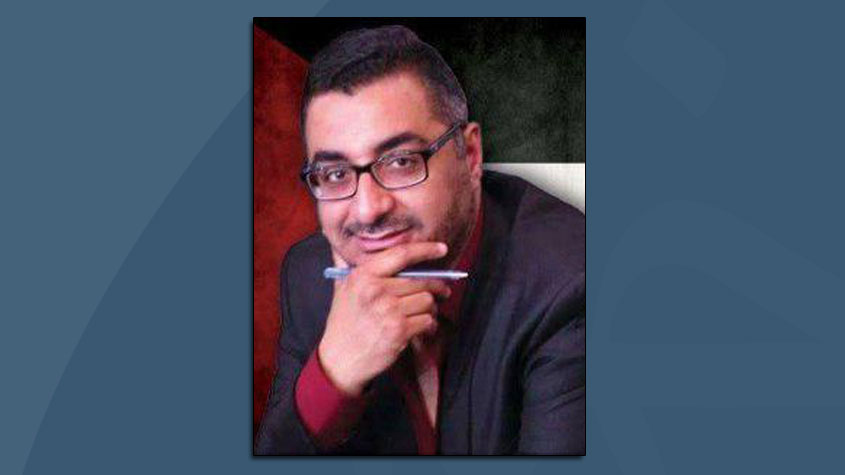
أحمد الدبش
قبل عشرين عاماً تقريباً، أصدرت كتابي «موسى وفرعون في جزيرة العرب»، أردت في كتابي هذا، إثبات أن المسرح الجغرافي للكتاب المقدس في اليمن، بالقول: إن «خروج قوم التوراة ظل حتى وقت قريب حبيس الأسطرة، بيد أن ثمة إشارات غامضة في الكثير من النقوش تدعم، وإلى حد بعيد فرضية حدوث هذا الحدث (خروج قوم التوراة)، وسوف ينصبّ بحثنا على إدراج حادثة الخروج ضمن جغرافية الحضارة اليمنية القديمة، والتي كانت تشمل عُمان واليمن الحالي وبعض السواحل السعودية». وحاولت في كتابي «كنعان وملوك بني إسرائيل في جزيرة العرب»، الذي صدر في عام 2005، تتبُّع ملوك بني إسرائيل، والبحث عن أورشليم، والبحث عن دولتَيْ إسرائيل ويهوذا، في إطار الجغرافيا اليمنية. وقدمت في كتابي «اختطاف أورشليم»، الذي صدر في عام 2013 الدليل على أن أورشليم يمنية، ويُعتبر هذا الكتاب استكمالاً لكتابي «كنعان وملوك بني إسرائيل في جزيرة العرب». وأكدت في كتابي «بحثاً عن النبي إبراهيم»، الذي صدر في عام 2015، أن المسرح التاريخي والجغرافي للنبي إبراهيم كان في اليمن.
استندت لإثبات أطروحتي هذه إلى العديد من الركائز:
أولاً: الأبحاث الأثرية التي مسحت مصر وفلسطين والعراق، منذ عشرات السنين، والتي لم تعثر على أقل أثر يؤكد الأحداث التوراتية في هذه المناطق.
ثانياً: المصادر التاريخية العربية القديمة.
من أهمها:
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ، ( 310 هـ / 923 م ).
- الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، الملقب بـ «لسان اليمن» ( 280 هــ / 892 م إلى 360 هـ / 970 م ). ومن أهم مصادره التي اعتمدنا عليها، كتاب «صفة جزيرة العرب»، وكتب «الإكليل».
- نشوان بن سعيد الحميريّ (عاش في القرن الثّاني عشر الميلادي)، في كتابه «قصيدة نشوان الحميريّ وشرحها، ملوك حمير وأقيال اليمن».
- جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب أبي محمد ابن المجاور الشيباني الدمشقي (أحد مؤرخي القرن الثالث عشر للميلاد)، في كتابه «صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر».
ثالثاً: المصادر الدينية.
- القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس.
رابعاً: من الناحية اللغوية.
فقد اعتمدنا على مصدرين رئيسين هما:-
- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، صاحب «لسان العرب».
- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، صاحب «مختار الصحاح».
خامساً: النقوش المسندية.
لقد اعتمدنا على بعض الإشارات الغامضة في النقوش المسندية المتأخرة، والتي لم تكن متزامنة مع أحداث الكتاب المقدس، لمحاولة تأكيد فرضية «خيالية»!
لا شك في أن علامات التسرع والارتباك ظاهرة في نصوص كتبي المبكرة، لأني ألّفتها وقتها متأثراً بـ «خطأ تحديد جغرافية الحدث التوراتي»، فكيف لي كباحث في التاريخ القديم، أعتمد «الكتاب المقدس»، كوثيقة تاريخية، وأقر أن المشكلة تكمن، وبكل بساطة، في خطأ تحديد جغرافية الأحداث؟ كيف لي كباحث في التاريخ القديم، رفض إسقاط روايات «الكتاب المقدس» على فلسطين لانعدام الدليل الأثري، وفي ذات الوقت أخترع جغرافية بديلة دون دليل أثري؟!
لقد احتوى بنائي التاريخي لنقل مسرح روايات «الكتاب المقدس» إلى اليمن، إذاً، على أخطاء هائلة. وهذا يعني بالطبع الاعتراف بأن أطروحتي ليست، أكثر من وهم، لا سند علمياً لها. فـ «الكتاب المقدس، بوصفِهِ نصاً مقدَّساً، لا يُوفِّر مصدراً تاريخياً، ولا يعكس بالضرورة، حقيقة عن الماضي». و«صورة ماضي إسرائيل، كما وردت في معظم فصول الكتاب العبري، ليست إلا قصة خيالية، أي تلفيقاً للتاريخ».
كيف أرفض إسقاط روايات «الكتاب المقدس» على فلسطين واخترع جغرافية بديلة بلا دليل أثري؟
وفي الواقع لم يحدد القرآن الكريم، الأماكن الجغرافية، ولا الأزمنة التاريخية، التي عاش في رحابها «بني إسرائيل». في هذا السياق يقول د. محمد أحمد خلف الله، في أطروحته «الفن القصصي في القرآن» ما يلي: «المعاني التاريخية ليست من مقاصد القرآن في شيء ومن هنا أهمل القرآن مقوّمات التاريخ من زمان ومكان وترتيب الأحداث. إن قصد القرآن من هذه المعاني إنما هو العظة والعبرة أي في الخروج بها من الدائرة التاريخية إلى الدائرة الدينية. ومعنى ذلك أن المعاني التاريخية من حيث هي معانٍ تاريخية لا تُعتبر جزءاً من الدين أو عنصراً من عناصره المكوّنة له. ومعنى هذا أيضاً أن قيمتها التاريخية ليست مما حماه القرآن الكريم ما دام لم يقصده. حين وصل العقل الإسلامي إلى هذه المرحلة من التفكير كان قد وصل إلى حيز كثير، ذلك لأنه كان قد قطع شوطاً طويلاً في سبيل تحرُّر العقل الإسلامي من هذا المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني. وكان قد وصل إلى القضاء على القصد التاريخي والقضاء على هذا القصد قد جلب للعقلية الإسلامية الفوائد التالية: (1) التحرُّر من الإسرائيليات والتخلُّص من كثير من هذه الفروض النظرية. (2) توجيه الذهن البشري إلى ما هو المقصود من القَصص القرآني من المواعظ».
هنا يلفت انتباهنا ما جاء في «تفسير المنار، الجزء الأول»، للشيخين محمد عبده ورشيد رضا: «إن القصص جاء في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين. وإنه ليحكي من عقائدهم الحق والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ومن عاداتهم النافع والضارّ لأجل الموعظة والاعتبار».
هكذا، وبعد سنوات طويلة من العمل الجاد في مجال البحث التاريخي، تبين لي خطأ هذه الأطروحة، وسقوطها أمام الأدلة العلمية، فلم يكن اليمن المسرح الجغرافي لإبراهيم، ولم يشهد خروج موسى وجماعته، ولم يتم تدمير مدنه على يد يوشع بن نون، ولم تحتضن الجغرافية اليمنية أياً من ملوك بني إسرائيل، ولا يوجد دليل أثري يشير صراحةً، أو ضمنياً، إلى وجودِ المملكة الداوديَّة ـ السليمانيَّة، ولم تذكر النقوش اليمنية أحداث «الكتاب المقدس»، ولا توجد نقوش متزامنة مع الأحداث «المُتخيلة» التي وردت في «الكتاب المقدس».
ثمّة حقيقة مهمة، تكمُن في أنّ قرناً من البحوث الأثريّة المكثَّفَة؛ لم يتمكن من تقديم البُرهان على أن أحداث «الكتاب المقدس»، وقعت سواء في فلسطين أو في خارجها، وأي ادعاء بغير ذلك غير صحيح على الإطلاق وتزوير للحقائق.
ولا يقتصر الأمر هنا على الجانب التاريخي فحسب، بل أساساً على الجانب السياسي الراهن بامتياز.
وأخيراً، أختم بما قاله أبو علاء المعري:
فَذاكَ أَوانُ تَخضَرُّ الرَّوابي
لِناظِرِها وَتَبيَضُّ الوِذارُ.
أَيُلقى العُذرُ أَم أَبَتِ الخَطايا
قَديماً أَن يَكونَ لَكِ اِعتِذارُ
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2021/06/25




















