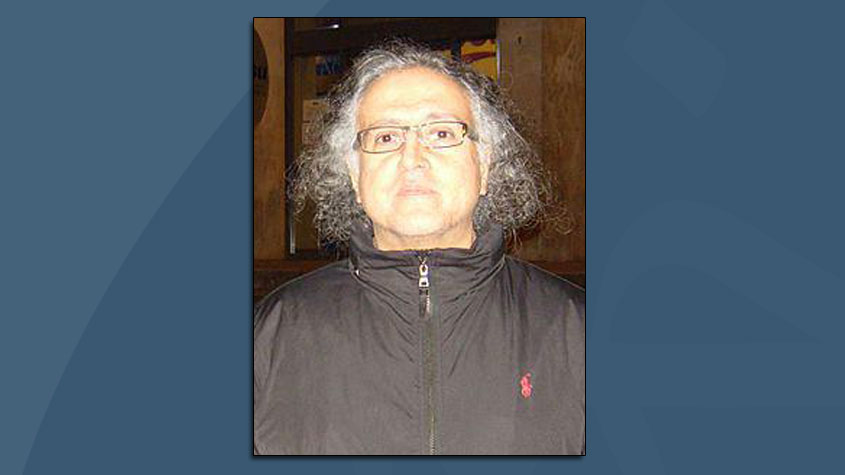الحرب العربيّة الكُبرى؟ وَقعُ ترامب
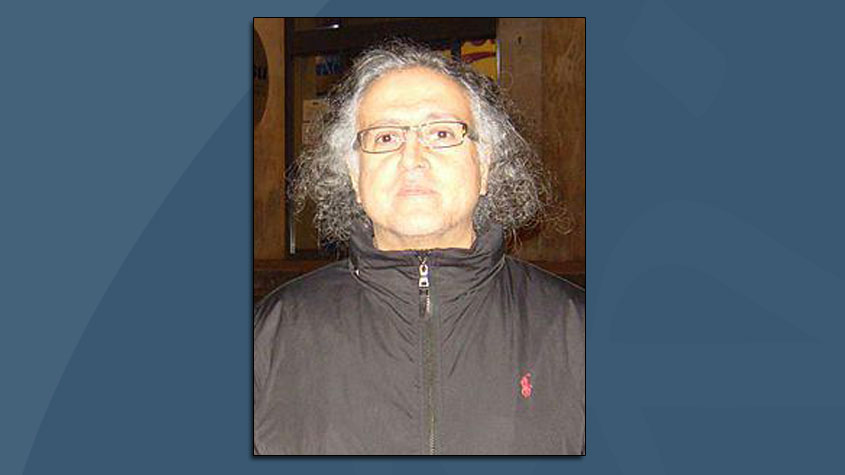
أسعد أبو خليل
اشتعال الأزمة بعد زيارة ترامب ليس صدفة (أ ف ب)
لم تبدأ هذه الحرب العربيّة الكبرى في اندلاع الصراع السعودي ـ الإماراتي ضد قطر. الحرب هذه بدأت منذ أن أعادت أميركا رسم الخريطة السياسيّة للعالم العربي بعد موت عبد الناصر. فسّخت العالم العربي وشطرته إلى معسكرات متنازعة اعتماداً على معيار الصلح مع العدوّ الإسرائيلي.
العالم العربي يُعاد تركيبه وتفكيكه وشطره. والجيل الجديد من أبناء الحكّام يحلمون بقيادة المنطقة خلف أميركا وحليفتها إسرائيل. الصراع هذا هو صراع على خلافة أميركا في منطقتنا، في جوانب منه. لم تعِد أميركا الكرّة في نشر جيوشها واجتياح بلداننا لأنها هُزمت - بصريح العبارة - في العراق وأفغانستان. لن يُقال على طريقة فييتنام إن أميركا لم تُهزم لكن لم تدفع بكل قوّتها، أو أن الشعب لم يكن مسانداً. لا، هي دفعت بكل قواها والشعب كان مسانداً، وانسحبت من العراق جارّة أذيال الخيبة. أميركا تحتاج إلى من يدير المنطقة بالنيابة عنها، ولِمن يموت أيضاً بالنيابة عنها. الطامعون كثر.
الصراع في الخليج يدور على مرّ تاريخنا المعاصر على أكثر من مستوى: ١) مستوى الصراع بين السلالات، وهو لم يوفّر علاقة بينهما وتطوّرت عبر العقود إلى حشود عسكريّة وحروب (مثل حروب البريمي، عندما قرّرت السعوديّة في أوائل الخمسينيات أن البريمي هي لها لأن النفط اكتُشف فيها. ولأن البريمي تقع في حدود مشتركة مع عمان وأبو ظبي، طلبت السلالتان الأخيرتان من بريطانيا أن تفاوضا السعوديّة بالنيابة عنها). وهناك خلاف حدودي (واحد على الأقل) بين كلّ هذه السلالات (عبد الرحمن الراشد ذكّر أمس أن قطر نازعت البحرين حتى في ١٩٩٠ عندما كان الحديث عن غزو الكويت). ٢) الصراع بين أجنحة في السلالات الحاكمة. لا نعلم الكثير عن هذا الموضوع بسبب سريّته، لكن الأجنحة هي المدخل للكثير من القوى الخارجيّة للتدخّل والتأثير وإخراج البديل والمعاقبة. لا نعلم حقيقة الدور الأميركي في تركيب جناح السديريّين مثلاً. ٣) الصراع بين المُستعمِر والسلالات على الحصص وعلى درجة الولاء للمُستعمِر (مثل صراع عبدالله آل ثاني مع الاستعمار البريطاني في عام ١٩٣٨، عندما طالب ببعض السيّارات المصفّحة لأغراض الأمن وفق اتفاقيّة تجديد الحماية التي وُقّعت في عام ١٩٣٥، ورفضت بريطانيا الطلب لأن الحفاظ على الأمن كان - برأيها - من اختصاصها هي (راجع «فصول من تاريخ قطر السياسي»، لأحمد زكريا الشلق، ص. ٨٥)). ٤) الصراع بين السلالات وشعوبها (بلغت درجة الشك والريبة في السعوديّة من قبل السلطات بعد اندلاع الثورة في اليمن في عام ١٩٦٢ إلى أن سلاح الجوّ تم وقف العمل به كليّاً بعد أن انشقّ تسعة طيّارين سعوديّين ولجأوا للنظام الناصري، واستعانت السعوديّة بسلاح الجوّ الأميركي عوضاً عن سلاحها «الوطني» (راجع «شبه الجزيرة العربيّة بلا سلاطين» لفريد هاليدي، ص. ٦٧). ٥) الصراع بين معسكر دول الخليج - على تنافرها - وبين دول عربيّة أخرى، كما حدث في الخمسينيات والستينيّات عندما تخوّفت السلالات الحاكمة وحماتها في الغرب من المدّ الناصري وانعكاسه على الوضع في الخليج. ٦) الصراع المُستحدث بين دول الخليج وإيران، والذي كان أقلّ حدّة في عصر الشاه بسبب الولاء المشترك للحاكم الأميركي.
أما هذه المرحلة من الصراع الحالي، فهي للسيطرة على كل العالم العربي. ميزان القوى الذي يحكم المنطقة زال من الوجود بتساقط منافسي آل سعود (العرب)، الواحد تلو الآخر. بدأت السعوديّة بالسيطرة على الجزيرة العربيّة في عام ١٩٦٧ بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن، وتشارك الحكم السعودي مع إيران وأميركا وقوى الغرب والرجعيّة العربيّة في محاربة أيّ نفوذ تقدّمي في شبه الجزيرة. بدّدت هزيمة ١٩٦٧ الطموح الناصري القومي العربي، لكن صعود الثروة النفطيّة في العراق وليبيا والجزائر قوّض من حلم نشر «الحقبة السعوديّة» في كل العالم العربي. كان صدّام حسين يحلم هو أيضاً بالسيطرة على العالم العربي، كما معمر القذّافي (الذي أصبح أفريقيّ الهوى في سنواته الأخيرة بعد أن يئِس من إمكانيّة قيادة الجماهير العربيّة). أما طموح حافظ الأسد فتركّز على لبنان وفلسطين وسوريا، ربّما بسبب شحّ الموارد الماليّة نسبيّاً. وفي عام ١٩٩١، قاد حسني مبارك العالم العربي بالنيابة عن الإدارة الأميركيّة لتسهيل حرب الخليج الأولى، أي تسهيل الدخول الأميركي الكبير في المنطقة العربيّة (ومن دون معارضة تُذكَر من أي دولة عربيّة). وفي ذلك الحديث بين الملك فهد وعبدالله بن عبد العزيز وديك تشيني في ١٩٩٠، عندما هوّل الأخير على الملك وطلب دعوة رسميّة منه لنشر قوّات أميركيّة، علّق عبدالله في همسة سمعها المُترجم الأميركي أن أميركا لن تخرج من الجزيرة متى دخلت. لم تخرج أميركا، لكن طبيعة الدور الأميركي تغيّرت في هذه الإدارة الجديدة.
هناك مفارقة في أنّ الدولتين الوهابيّتين الوحيدتين في العالم تتصارعان
وفي مرحلة الانتفاضات العربيّة، تعاملت السعوديّة مع الحدث بجزع وخشية كبيريْن. توافق النظام المصري والحكومة الإسرائيليّة على أن أميركا خذلت حليفاً كبيراً لها في السماح للشعب المصري بإسقاطه (طبعاً، حاولت أميركا الحفاظ عليه، كما حاولت أن تحافظ على بن علي، لكن أميركا - حفاظاً على مصالحها هي - ترضخ أحياناً للأمر الواقع وتبرز نفسها كداعمة لحق الشعوب). لكن قطر هي التي قادت الثورة العربيّة المُضادة التي حوّرت الإرادة الشعبيّة العربيّة المنتشرة باتجاه رجعي ديني إخواني (هذا لا ينفي أن لـ«الإخوان» شعبيّة ونفوذاً في الرأي العام العربي). قطر قادت بنفسها جامعة الدول العربيّة في المرحلة الأولى التي تلت الانتفاضة التونسيّة، وكأن السعوديّة والإمارات سلّمتا بالمشيئة القطريّة التي لم تكن تُردّ. قطر، لم تكن بعيدة يومها عن محاولة السيطرة على مقدّرات العالم العربي. «الجزيرة» وسطوتها ونفوذها، مستندة إلى ثروة غازيّة هائلة، عظمّت من طموح دولة لم تكن تطمح بأكثر من الحفاظ على نظام الحكم فيها، وعلى إرضاء الحامي الغربي ومنع الأذى السعودي المجاور. لكن قطر هي التي علّمت شقيقاتها لعبة الطموح المتعاظم والتوازن العلني والخفي.
وبعد انقلاب ١٩٩٥، سجّل حمد بن خليفة سابقة في تقديم خليط متنافر من السياسيات: قامت الحكومة الجديدة بتقديم أراضيها لقواعد عسكريّة أميركيّة، وتكون السيادة فيها مطلقة للحكومة الأميركيّة. لا تعلم الحكومة المُضيفة ما تقوم به القوّات الأميركيّة ومَن يساندها مِن مخابرات مرتبطة بها. وكانت الحكومة القطريّة تقدّم هذه الحماية على أنها ضمانة لها تجاه الجار السعودي الذي لم يرضَ بتغيير الحكم، وحاول تغيير التغيير. ولم يكتفِ الحكم الجديد بذلك، بل دشّن علاقات علنيّة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في فرضيّة أن التقرّب من واشنطن يزداد قرباً من خلال التقرّب من تل أبيب (هذه الفرضيّة حكمت تصرّف معظم الدول العربيّة ومنظمّة التحرير). وفي المقابل، في محاولة لإحداث توازن مصطنع - لكن ذكي (من منظورها هي) - أنشأت الحكومة القطريّة محطة «الجزيرة» بعد سنة واحدة من الانقلاب وأعطتها وجهة قوميّة عربيّة، كما أبدى الخطاب القطري الرسمي تعاطفاً مع حركات المقاومة (لكن مع وجود تطبيع صريح مع العدوّ من خلال استضافة ممثّليه على «الجزيرة»)، ومع حرص على عدم دعم حركات المقاومة بالسلاح. حركة «حماس» اعتمدت على تسليحها من مصادر غير قطريّة (إيران وسوريا وحزب الله)، أي أن قطر حرصت على عدم مخالفة المشيئة الأميركيّة وقوانينها حول حظر دعم ما تسمّيه أميركا والعدوّ الإسرائيلي بالإرهاب. ومحطة «الجزيرة» بلغت أوجها حتى ٢٠٠٣: كانت نسبة مشاهدتها تصل إلى أكثر من نصف المشاهدين العرب، وكان خطابها حماسيّاً ومستضيفاً لوجهات نظر المعارضات العربيّة، باستثناء قطر، ومن دون الحديث الجذري عن الاقتصاد السياسي وعن ثروات الغاز والنفط.
لكن الموازنة المصطنعة لم يكن لها أن تستمرّ. الحليف الأميركي والجار الخليجي لم يرضيا بالتوليفة الصعبة. عدّلت قطر من عقيدتها، وزادت من المنسوب الإسلامي في «الجزيرة» (إذ أنه كان أقل معارضة للاحتلال الأميركي في العراق، وأقلّ معارضة للتطبيع مع العدوّ)، وسمحت لوزارة الخارجيّة الأميركيّة بإجراء نقد أسبوعي لبرامج «الجزيرة» من أجل تعديلها وتشذيب خطابها ومصطلحاتها وصورها بما يرضي الضيف العسكري الأميركي. وأجرت «الجزيرة» تغييراً جذريّاً في طاقم المحطة بطلب وضغط من المحتل الأميركي بعد ٢٠٠٣. أكثر من ذلك، عندما زاد اعتراض إدارة بوش على تغطية «الجزيرة»، دخلت قطر في تفاوض جدّي مع الإسرائيلي ـ الأميركي حاييم صابان، من أجل بيع المحطة له. (وسيصبح صابان هذا شريكاً لقطر في برامج مؤسّسة «بروكنز» الصهيونيّة فيما يتعلّق بالشرق الأوسط والإسلام وبإشراف مباشر من الصهيوني العتيق، مارتن إنديك، الذي تتلمذ على يد أركان اللوبي الصهيوني، قبل أن يُنشئ ذراعه الفكريّة «مؤسّسة واشنطن»). وتحسين العلاقات مع السعوديّة (ومع وزير الداخليّة في حينه، نايف بن العزيز، الذي حثّ على المصالحة لأنه كان يخشى من الأثر الأمني لبثّ المحطة تحريضاً ضد الحكم السعودي) ومع الحكم الأردني غيّر من تغطية المحطة.
وبحلول زمن الانتفاضات العربيّة، كانت قطر في موقع أضعف من قبل، لكن ضعف الجار السعودي سمح لها بالتفرّد في قيادة الجامعة العربيّة. لم تعد «الجزيرة» تلك المحطة ذات السطوة: فقد نشأت منافسات لها، والسوق الإعلامية عجّت بالمحطات المحليّة في كل الدول العربيّة، وهي باتت تجذب أكبر نسبة من المشاهدين العرب. و«الجزيرة» منذ أن سقط نظام بن علي، أصبحت جهاز دعاية إعلامية فجّة: أدخلت المحطة ظاهرة «المراسل-الناشط»، وقد يكون نشاط الناشط مسلّحاً وقد يكون النشاط جهاديّاً، لكن تغطيته مقبولة للمحطة. والتأجيج اللجوج لإسقاط مبارك أدخل نمطاً جديداً على برامج المحطة، أي التحريض السياسي المباشر وفق أجندة قطر.
وبعد سقوط مبارك ونجاح «النهضة» في تونس، خُيّل لقطر أنها على وشك الإمساك بمقدّرات العالم العربي. لم تخشَ واشنطن كثيراً، بل هي سمحت لها بأن تتوسّط بين فروع «الإخوان» في العالم العربي واللوبي الصهيوني في واشنطن. وتوالت زيارة «الإخوان» إلى واشنطن، والتقوا بالصهيوني المتطرّف، السيناتور جون ماكين. وجاء راشد الغنّوشي - القليل السفر - بنفسه مرتيْن في محجّة إلى اللوبي الإسرائيلي كي يُطمئِنهم بصريح العبارة أنه لن يسمح بتجريم أو تحريم التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي في الدستور التونسي الجديد، وأن السياسة الخارجيّة الجديدة لن تحيد كثيراً عن سابقتها. وطبعاً، أرادت واشنطن أن تتأكّد أن تعيين محافظ البنك المركزي سيبقى في يد البنك الدولي والسفارة الأميركيّة في البلاد.
وانتهج حكم «الإخوان» في مصر نهجاً مُشابهاً والتزم بالحفاظ على سيطرة القوّات المسلّحة على السياسة الخارجيّة والاستخبارات (أي أنه سلّم رقبته لأعدائه). لكن الحرب الليبيّة شهدت بداية تنافس بين دولة الإمارات وبين قطر، ممّا أشعل حرباً لم تنتهِ.
والحرب السوريّة كانت في عهدة الحكومة القطريّة وهي سهّلت، كما سهّلت الإمارات والأردن والسعوديّة - وبموافقة أميركيّة أكيدة - تسليح وتمويل وتنظيم فصائل متنوّعة الانتماءات الجهاديّة الإسلاميّة وبعناوين ثوريّة برّاقة (لم تمانع واشنطن رعاية قطر للتطرّف الإسلامي بل عوّلت عليه من أجل التواصل غير المباشر أو المباشر مع طالبان في أفغانستان أو النصرة في سوريا). لكن الصراع بين السعوديّة وقطر على الاستئثار بالمعارضة السوريّة (المُسلّحة منها والفندقيّة) لم يُحسم حتى الساعة، وزاد ذلك في الحزازات.
لا نعلم حتى الساعة السبب المباشر لانفجار الأزمة. من المشكوك فيه أن يكون تصريح واحد للأمير هو السبب (بصرف النظر إذا كان صحيحاً أم لا). لكن اشتعال الأزمة بعد زيارة ترامب ليس صدفة، لكنه لا يعني بالضرورة على أنّ المحرّك المُباشر هو أميركي. صحيح أن دول الخليج وحلفاء أميركا في الشرق الأوسط هم دول من دون سيادة - باستثناء دولة العدوّ التي يستطيع رئيس حكومتها أن يلقي خطبة في الكونغرس ضد الرئيس الأميركي ويحظى بالتصفيق المألوف في المجالس النيابيّة والشورويّة العربيّة. إنّ من مصلحة واشنطن الدعائيّة المبالغة في قدرتها على تحريك الأحداث والتطوّرات، كما أن مصلحة «الموساد» تكمن في المبالغة في سعة اطلاعها وتسييرها للشؤون والأحداث في العالم العربي. أميركا تصرّ على السيطرة الكاملة: وهي قرّرت في عهد جيمي كارتر أن مصادر الطاقة في الشرق الأوسط هي حلال لها، وأن تجربة قطع الإمداد عن دول الغرب لن يُسمح به مرّة ثانية (بعد التجربة القصيرة التي رافقت حرب تشرين)، وأن القوّة المسلّحة ستكون جاهزة للردّ على أي محاولة عقاب عربيّة.
أما تغيير الكراسي والإخلال بالتراتبية السلاليّة فهي أمور تسمح بها أميركا لعلمها أنها مستفيدة في كل حال، على طريقة «إمطري حيث شئتِ فخراجك لي». هي سمحت بإقصاء حليفها وحليف إسرائيل، الأمير حسن في الأردن وتعايشت مع انقلاب قطر في ١٩٩٥، كما انها لم تتخذ موقفاً متشدّداً من مسألة الخلافة في السعوديّة إذا كان واحداً من المحمديْن يستحقّها. هي كانت أقرب إلى محمد بن نايف بسبب تاريخ من التعاون في القمع والقتل والملاحقة، لكنها سرعان ما تأقلمت مع صعود محمد بن سلمان، لأن الطامح يسعى لتعزيز موقعه عبر إرضاء واشنطن (أو بريطانيا قبل ذلك) أكثر (وهذا ما فعله فيصل وجناح السديريّين في عام ١٩٦٤، وما فعله قابوس عندما أقصى أباه في عام ١٩٧٠). ومحمد بن زايد أسّس لشراكة عسكريّة ــ استخباريّة قويّة مع الأميركيّين والإسرائيليّين (لا شك أنه كان متواطئاً في اغتيال المبحوح، كما أن السجال حول شركة «موانئ دبيّ» قبل سنوات في الكونغرس الأميركي كشف عن خدمات كبيرة تقدّمها حكومة الإمارات إلى أميركا، بما فيها استضافة أكبر محطة للمخابرات الأميركيّة خارج الأراضي الأميركيّة).
هذه المرحلة من الصراع الحالي، هي للسيطرة على كل العالم العربي
ومحمد بن زايد استعمل نفوذه في واشنطن لدعم خلافة ابن سلمان على ابن عمّه (وقد ابتاع نفوذه عبر التعاون العسكري ــ الاستخباراتي وعبر الإنفاق السخي على الدعاية و«العلاقات العامّة» وخصوصاً على مراكز الأبحاث التي بدت هذا الأسبوع كفروع لسفارة أبو ظبي. اتضح من مراسلات العتيبة كم أن إغراءات المال والهدايا تشتري من المسؤولين السابقين والإعلاميّين والخبراء - مثلما كان سفير الشاه، أزدشير زاهدي يفعل في سنوات خدمته في واشنطن، عندما ابتاع كبار الصحافيّين عبر هدايا السجّاد العجمي والكافيار والفستق والرحلات المجانيّة، كتب عن ذلك جيمس بيل في كتابه «النسر والأسد» عن العلاقات الأميركيّة ــ الإيرانيّة في عهد الشاه).
وهناك أسباب أخرى عديدة ومتراكمة: الصراع على النفوذ في المشرق والمغرب بين قطر من جهة وخصومها من جهة أخرى (وليست السعوديّة والإمارات متفقتين أبداً على كل الملفّات). وهناك تسديد حسابات من قبل السعوديّة التي تشهد جموحاً وتوحشّاً وثأريّة وجسوراً لم تشهدها في تاريخ سياساتها الخارجيّة (وهي تزيد حالة العداء ضدّها، حتى في دول الجوار حيث ظهر من الكويت تعاطفٌ أكبر نحو قطر). أما المعلّق جيك نوفاك في موقع «سي. إن. بي. سي» الأميركي، فيرى أن الخلاف ينحصر في موضوع محاولة سعوديّة ــ إماراتيّة لخدمة مصالح إسرائيل عبر هذا الإصرار الفجائي على طرد «حماس» وقطع العلاقة معها (وهذا الشرط لم تكن حتى أميركا الصهيونيّة تصرّ عليه، أي أن صهيونيّة أولاد زايد وصهيونيّة شلّة خدمة الحرميْن باتت فوق صهيونيّة راعية دولة الاحتلال الإسرائيلي). والاحتضان الإماراتي لمحمد دحلان نتاج وليس سبباً للتقرّب بينها وبين دولة العدوّ.
لكن زيارة ترامب لها تأثيرها أيضاً. اكتشفت دول الخليج المعنيّة أنها أمام إدارة جديدة تترك حريّة التحرّك - ضمن سقف المصالح الأميركيّة الإسرائيليّة - لدول الخليج على أن تقوم الأخيرة بتسديد أكبر للنفقات ولمحاربة كلّ من تصنّفه أميركا عدوّاً. كانت أميركا تضبط من سلوك دول الخليج ليس حفاظاً على الأخلاقيّة بل على مصالح تلك الدول، ومصالحها هي من أمامها ومن ورائها. ترامب أفهمهم بصريح العبارة أنه سيتركهم وشأنهم (أي أن أمر الإصلاح الطفيف والتجميلي لا يعنيه، كما حلّ الصراعات بينهم كما مسألة المنافسة) على أن يسدّدوا نفقات الحماية الأميركيّة ويتقرّبوا أكثر من دولة العدوّ. لكن كان ملاحظاً في لقائه مع أمير قطر في الرياض خلال رحلته، أنه قال للإعلاميّين إنه سيحدّث الأمير عن أسلحة «جميلة» يمكن أن تبيعها أميركا لقطر. لكن اللقاء لم يثمر عن إعلانات عن صفقات سلاح، كما حدث مع الحليف السعودي.
يشعر الحليفان اللدودان (السعودي والإماراتي) أن أمامهما فرصة للسيطرة على كل العالم العربي والمشاركة (الدونيّة حتماً) مع دولة العدوّ في حكم الشرق الأوسط. والسيطرة على شبه الجزيرة هو مقدّمة لترتيب البيت العربي حسب المشيئة السعوديّة ــ الإماراتيّة (ومتى تمّ ذلك - لو تم - سيستعر الخلاف المستحكم بين الدولتيْن، وقد يستعر قبل ذلك). إن التعبير عن الضغينة والحقد ضد قطر في الإعلام السعودي سيؤشّر لباقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن الثقة بالحكم السعودي في غير محلّها، على الدوام. وانعدام الثقة لن يعزّز السيادة المحليّة بل سيزيد من الاستعانة بالجيوش الخارجيّة على أنواعها (ماذا لو اشتبكت القوّات الأميركيّة المتواجدة في قطر مع القوّات الأميركيّة المتواجدة في السعوديّة يوماً ما؟).
ليس الصراع الجاري صراعاً وطنياً. ليس هو صراع على القرار السيادي أو على القضيّة الفلسطينيّة أو على الإصلاح والتنمية. يتصارعون ويتنافسون بالأميركي. الإعلام السعودي يعيّر قطر بأن أميركا غير راضية عنها، والإعلام القطري يردّ مُستشهداً بتصاريح لمسؤولين في الحكم الأميركي و«الناتو» بأن قطر مرضيّ عنها. و«الجزيرة» تستهلّ النشرة بخبر اتصال ترامب بأمير قطر (وتستضيف مَن يحلّل ذلك ويهلّل له) و«العربيّة» تستهلّ النشرة بخبر اتصال ترامب بالملك السعودي (وتستضيف مَن يحلّل ذلك ويُهلّل له). لا شكّ أن الصراع الجاري هو - في جانب منه أيضاً - صراع بين سياسات أميركيّة متضاربة (بين أوباما - وظلّه في دولة المخابرات لا يزال قويّاً - وبين ترامب): بين تلك التي توافق على سياسة التواصل والتعاطي المباشر مع إيران، وسياسة الاشتباك والحرب ضد إيران. وهذا التضارب جار أيضاً في داخل الإدارة الأميركيّة. كانت السفيرة الأميركيّة في الدوحة تغرّد مؤيّدة الحكومة القطريّة، فيما غرّد ترامب نفسه مؤيّداً - للوهلة الأولى - سياسة السعوديّة والإمارات ضد قطر. لكن ترامب عاد في اليوم التالي ليتصل بأمير قطر عارضاً وساطته، لعلمه أن السياسة الأميركيّة وحروبها تعتمد على كل أنظمة الخليج، وأن الصراع فيما بينها يفيد أميركا: كلّما زاد التهديد ضد دولة منها من دولة أخرى، كلّما هرعت تلك الدولة لترتمي أكثر في الحضن الأميركي.
هناك مفارقة في أن الدولتين الوهابيّتين الوحيدتين في العالم العربي تتصارعان (هذا مثل الصراع بين فرعيْ «البعث» في سوريا والعراق). صراع متشاركي العقيدة أشدّ وأمرّ من صراع المختلفين في العقيدة. وهناك مفارقة في أن قطر تستعين بالقوّات التركيّة والأميركيّة في صراعها مع السعوديّة، التي تستعين بالقوّات الأميركيّة (والإسرائيليّة إن دعت الحاجة). والحلّ سيُفرض على الدولتيْن من الراعي الأميركي. وحدها أميركا ستفرض الحلّ باتجاه المزيد من الطاعة لأجندتها، وقد تضطرّ قطر لإعلان صفقات أسلحة باهظة الأثمان لإدارة ترامب. ودول الخليج مجتمعة أكثر خطراً وأفدح ضرراً على العرب من انقسامها. فلندعُ لهم بطول انقسام.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2017/06/10