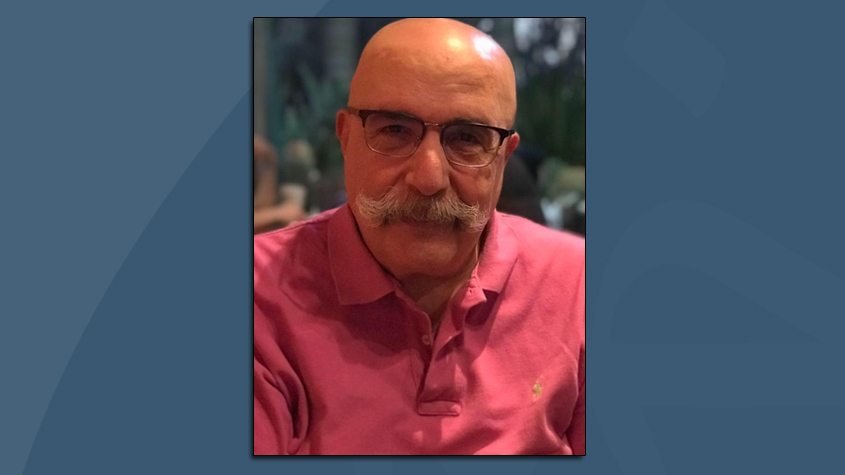في جذور العلاقة الأميركية ــ الاسرائيلية
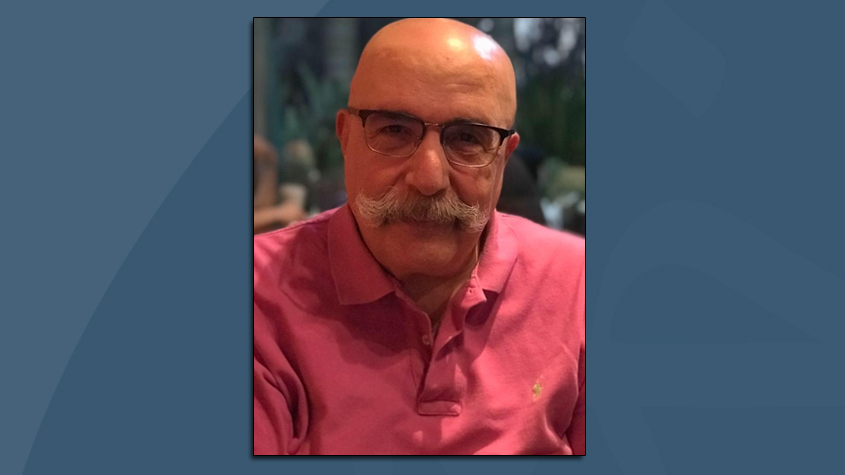
كمال خلف الطويل
عسير على السمع أن ترتطم الأذن بتردّد ناشز عن معتادها، يعيد زيارة دهاليزها، زوايا وتعرّجات، على وقع إيقاعٍ يصل الجِدّة المكتسبة، بالوقائع المشهودة... بوتر من مسد، ولتكون حصيلة الأمر قراءة مستنيرة لا تشرح ما جرى فحسب، بل تعين في فهم الجاري، لا بل تطلّ على استيلاد الآتي من رحمه.
الحديث هنا عن ماهية العلاقة بين أميركا ومشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، وصولاً إلى قيام الكيان الإسرائيلي، ثم إلى اعتماده حليفاً كامل الأوصاف... ولماذا وكيف.
كانت أميركا المجتمع، في ثلاثينات وأربعينات بل وخمسينات العشرين، ذات ثقافة مسيحية لم تختلط بأمشاجها بعدُ التأثيرات اليهودية، والتي لبثت إلى ما بعد ٦٧ كي تدعى «الثقافة المسيحية اليهودية». كان هناك نوع من تمييز ديني / إثني ضد اليهود، تجلّى ليس في تقييدات الهجرة المتعدّدة فحسب، بل في أشكال التمييز الاجتماعي التقليدية، في أماكن الدراسة والعمل والخدمات، وفي تجاهل نتائج المحرقة النازية النسبي، طيلة سنوات الحرب الثانية، (بسبب تركيز روزفلت على الانتصار في الحرب، لا سواه، وكما بدا في فرض حصار الجيش الأميركي على معسكرات الاعتقال النازية).
ومع انتهاء الحرب، حلّ التفجّع محلّ التجاهل، ليرشح معه في نسيج المجتمع وخلاياه الحية، رويداً رويداً، شعور أنّ النفور ــــ الديني الجذر ــــ لا ينبغي أن يحجب تقبل «الآخر" اليهودي، ولا سيما أنّ إسهامه في حقول الإبداع والعلم والخدمة ملحوظ، وباعتبار المحنة الكبرى التي عاشها بنوه في أوروبا للتوّ. كان انخراط الولايات المتحدة في الحرب الثانية، ذاته لحظة الانبعاث الكبير للحركة الصهيونية اليهودية الأميركية، بدءاً من مؤتمر بيلتمور في نيويورك بعد ستة أشهر من بيرل هاربر، وانصبّ تركيز الحركة على تمكين إقامة كيان يهودي في فلسطين، عبر تيسير هجرة يهود أوروبا إليها، وهو ما استدعى دوراً أميركياً فاعلاً يحيّد أي عائق في الطريق، أكان تحفّظاً بريطانياً أم معارضة عربية أم سواهما.
كان أقوى مثال على نفوذ جماعة الضغط الصهيونية، هو نجاحها في تسخير هاري ترومان، عام1946، للضغط على بريطانيا كي تتيح هجرة 100 ألف يهودي إلى فلسطين ــــ الانتداب. ما بين عامي 1945 و1947، اعتنق ترومان فكرة إنشاء دولة ثنائية القومية في فلسطين، لكنّ جماعة الضغط تلك نجحت، ثانيةً، في تطويعه لمطلبها: دولة يهودية في فلسطين، ونقطة. عامها ــــ 1947 ــــ كان شعور العطف بين «النخب» قد مكّن الجماعة تلك من «إقناع» ترومان بدعم مطلبها، فكان قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947. والحال أنّ ترومان قد احتفظ بتحفّظه على التقسيم, كما ردّد مراراً في أحاديثه الخاصة، مشيراً إلى نفوذ سياسي زائد للجماعة.
نالت كلّ من مسألتي الهجرة والتقسيم معارضة «دولة الأمن القومي»، بقناعة أنّ كياناً يهودياً في فلسطين مشروع مستحيل في ضوء رفض عربي تام له، داخل وحول فلسطين بل وأبعد، وأنّ مصالح الولايات المتحدة المتّسعة في الإقليم ستكون من بين ضحاياه.
ورغم اجتياح فورة النخب العاطفية، ممثلاً في نجاحها بتمرير قرار التقسيم (لافت هنا أن الضغوط على وفود دول العالم الثالث مارستها في الأساس نخب أميركية غير رسمية ــــ مثال مدير «فايرستون»)، إلا أنّ جملة حوادث ومواقف حفلت بها تلك الآونة، والأشهر الستة اللاحقة لها، كان أهمّها إقالة دولة الأمن القومي نفسها من عثرتها بأن دعت إلى حوار البنتاغون، في خريف47، بين رجالاتها ونظرائهم في الدولة البريطانية العميقة. كان الاعتراض على قرار التقسيم سائداً، لكنّ مغالبته للتوّ عسيرة... ومن ثمّ التريث إلى حين، ثم العودة لمقاربته بالتجاهل والانطلاق إلى بدائل.
جملة إضاءات هادية تنفع هنا في جلو غشاوة الصورة:
1 ـــ ليس صحيحاً أنّ واشنطن قد ابتغت طرد بريطانيا من «الشرق الأوسط»، في أعقاب الحرب الثانية. هي قبلها وبعدها قاومت ومنعت مخططاتها للسيطرة على الشمال العربي: مشروعا سوريا الكبرى والهلال الخصيب، وتلاكمت معها بالنقاط في سوريا: انقلاب لأجل هذه يتلوه انقلاب لصالح تلك... ثم في الأردن: طرد غلوب باشا؛ كل هذا صحيح، لكن ما كان مقبولاً ـــ لا بل مرغوباً ـــ هو دور بريطاني متّسق ومسقوف. ما الذي عناه ذلك في عام 1947 وما تلاه؟ عنى أن تبقى القوات البريطانية في فلسطين، لا أن تلحق بالتي سحبت قبلاً من الهند. وبذا تمنع نشوء كيان يهودي في فلسطين. المهم أنّ ذلك كان مخالفاً لقرار حكومة حزب «العمال» الانسحاب من فلسطين، منتصف أيار / مايو 1948.
2 ـــ كان للجنرال جورج مارشال، وزير الخارجية، مؤيداً بجيمس فورستال، وزير الدفاع، دور قيادة الجهد الأميركي في إعادة التقييم ومحاولة قلب المائدة. تكثّف ذلك في رعايته مشروع قرار أميركي يصدر عن مجلس الأمن، وينصّ على طي قرار الجمعية العامة للتقسيم وفرض انتداب دولي على فلسطين، عبر مجلس الوصاية الدولي. كان ذلك في آذار / مارس 1948.
هبّت الجماعة والنخب برأس رمحها، كلارك كليفورد مستشار الرئيس، لثني ترومان عن إسناد مارشال، وفازت. شابه ذلك في لندن إصرار حكومة «العمال» على انسحاب قواتها من فلسطين في موعده. وبرغم صهيونيتها، إلا أنّ ذلك لم يعفها من سخط إرهاب اليمين اليهودي، الذي حاول اغتيال كليمنت إيتلي وإرنست بيفن، لكونهما قد أفاقا على مخاطر تبنّي المشروع الإسرائيلي وفق هوى أصحابه.
3 ـــ وعليه، فقد اعترف ترومان بـ«دولة» إسرائيل، اعترافاً واقعياً في اللحظات الأولى لإعلانها، في 14 أيار / مايو 1948. لكن ما يستحق الذكر أنه اعترف، كما ظهر على ورقة الاعتراف، بـ«حكومة مؤقتة» لا بـ«الدولة». أمرٌ انتظر حتى هدَن عام 1949، وقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
4 ـــ كانت المواجهات المسلّحة بين الجهاد المقدس والهاغانا، قد صارت ناموس الحال عبر الأشهر الأولى من عام 1948، وبتفوّق تكتيكي حاد للثانية. وعلى خلفية أنّ طبيعة العلاقة بين القوات البريطانية وبين الهاغانا، كانت قد وصلت إلى الحضيض، ما بين أعوام 45 و47، بفعل أعمال حرب العصابات التي شنّتها الثانية على الأولى، كانت الآبار مسمومة عند دخول العام الحاسم 1948. على خلفية ذلك، وفي ضوء رفضها تحوّل اليشوف إلى دولة، فإنّ عناصر الدولة البريطانية العميقة في المنطقة قامت بإفساح المجال أمام جيش الإنقاذ (قوة لواء) للدخول الآمن إلى شمال فلسطين، في كانون الثاني / يناير 1948، وتوفير بعض المعلومات والسلاح له. ولما لمست أنّ «الإنقاذ» غير منقذ مضت إلى تشجيع، بل حث، دول الجامعة العربية على إدخال جيوشها في الحرب. وخلال فترة 46 ــــ 48، كان الجنرال كلايتون، مسؤول الاستخبارات البريطانية في المنطقة، شريكاً رئيساً في اجتماعات الجامعة العربية التي تناولت المسألة الفلسطينية. أسطع دور له كان في إقناع الملك فاروق بإرسال جيشه الى فلسطين، وقبل يومين فقط من موعد الانسحاب البريطاني. فتحت قوات القنال البريطانية الطريق فسيحاً أمام تقدّم القوات المصرية عبر سيناء، لا بل وتزويدها بالذخيرة والعتاد ووسائط النقل، بأمل أن تتمكن مع شريكاتها العربيات في حسر سيطرة اليشوف الجغرافية إلى شريط ساحلي صغير، يمتد من جنوب حيفا إلى تل أبيب فحسب.
كان أقوى مثال على نفوذ جماعة الضغط الصهيونية هو نجاحها في تسخير هاري ترومان عام1946، للضغط على بريطانيا كي تتيح هجرة 100 ألف يهودي إلى فلسطين
5 ـــ كان رضى الدولة العميقة في واشنطن كاملاً على جهود نظيرتها البريطانية في الميدان. وكان تقييمها أن اليشوف، ولو أنه متوفر على قوة فيلق وفرقة (60 ـــ 70 ألف مقاتل) عند بداية القتال النظامي، لكنّه لن يستطيع مواصلة تفوّقه العددي ولا النوعي، ما إن تتكاثر كالفطر أعداد متطوّعين عرباً ـــ قدّروها بـ200 ألف ـــ تثب إلى ساحة القتال مع تطوّر المعارك. معنى ذلك، أنّ هزيمة الهاغانا كانت محتملة في عرف البنتاغون، وهو سبب مضاف جعل من تبنّي المشروع الإسرائيلي وقتها ضرب حماقة.
6 ـــ تطوران قلبا تقييم البنتاغون أعلاه رأساً على عقب: غياب الـ200 ألف متطوّع عربي، وتبنّي ستالين تسليح الهاغانا (من دون إغفال دور مهم ـــ وإن أقلّ وزناً ـــ لإرساليات سلاح ومتطوّعين أتت من يهود الغرب، سيما الأميركي). أبدأ بستالين: حسَب أخينا وطرَح، فوجد أن اليشوف، الروسي / الشرق أوروبي في تكوينه، والذي قاتل الجيش البريطاني لعامين ونيف، والمعتنق فكراً يساري الطابع، يمكن له أن يكون قاعدة متقدمة للسوفيات شرق المتوسط، بالرغم من صهيونيته. في المقابل، تقبع الرسميات العربية داخل الجيبات البريطانية، من صغيرها إلى كبيرها، والنخبة الفلسطينية تفاعلت مع هتلر في وقته. وعليه، فلا آصرة معها، بل إنّ والسعي لضرّها واجب. هل تكفي تلك من أسباب لتفسير تحول ستالين من الدعوة إلى دولة ثنائية القومية في أيار / مايو 1947، إلى تبنّي قيام دولة يهودية بعدها بأشهر ستة، ثم إلى تسليح قواتها بكل ما احتاجت إليه، بعد ستة أشهر إضافية؟ هذا الافتجاء وتلك السرعة، معطوفة على إزواره السريع عن حميمية التبني بعد عامين فقط، تكوّنت بسبب نوعي مضاف. يثور سؤال، لا برهان عليه أو ضده بعد: هل عقدت موسكو صفقة مع اليهودية الأميركية، صيف عام 1947، تسلّمت بموجبه أسرار القنبلة الذرية لقاء تبنّيها إقامة ودعم إسرائيل؟ فلمّا فجّرت قنبلتها الأولى قضت وطرها ومضت. لافتٌ كيف عوملت السفيرة الإسرائيلية الأولى إلى موسكو، غولدا مائير، بخشونة عندما اكتُشف عام 1949، نسجُها صلات خارج المألوف مع نخب يهودية بغرض تنظيمها صهيونياً، كان بينها زوجة مولوتوف التي عزلت وسجنت. بدت إسرائيل موسكوبياً، عند بداية العشرية السادسة للعشرين، وكأنها فعل ماضٍ، لا مضارع.
7 ـــ لحظ البنتاغون أداء الهاغانا البارز (اللهم إلا في القدس القديمة التي هزمها فيها وطردها منها الجيش الأردني) طيلة أشهر الحرب السبعة، وكيف نمت عدداً إلى 110 آلاف مقاتل، وتوسّعت جغرافياً من مساحة الـ54%، الممنوحة لها بقرار تقسيم الأمم المتحدة، إلى 78% مع نهاية عام 1948. لقد وصل الحال في الجنوب إلى أن اخترقت الهاغانا القطاع الشمالي من سيناء واصلة إلى العريش، عند مفصل كانون الأول / ديسمبر 1948ـــ كانون الثاني / يناير 1949، مطوّقةً قوات الساحل المصرية (شيء شبيه بحال الجيش الثالث ـــ عام 1973) بالكامل. ولولا إنجاد ترومان لفاروق المستغيث به، لكان حجم الهزيمة أفدح وأذلّ.
8 ـــ كان استنتاج دولة الأمن القومي أن المشروع الإسرائيلي قد نجح في الاختبار، ويستحق الرعاية، لكنّ حجم المصالح الأميركية عند العرب ما زال وازناً إلى حدّ إعاقة تبنّيه حليفاً أو شريكاً بعد. من هنا، نأي واشنطن عن تزويد إسرائيل بالسلاح، ما بين عام 1949 و1962، ثمّ تسليحها بالقطعة ــــ أو بالواسطة: ألمانيا الغربية مثالاً ـــ ما بين عامي 1962 و1964، ثم الكرم الصريح فترة 1965 ـــ 1967. ثم الانهمار عليها بالغالي والثمين منذ عام 1967. توازى ذلك مع ارتفاع مقدار المشروع الإسرائيلي، والحاجة إليه، في عُرف واشنطن. في المقابل، أذنت واشنطن لفرنسا أن تكون مورد السلاح الرئيس لـ«تساحل» بعد إقامة إسرائيل، وهو ما تواصل حتى حربها في عام 1967. لا بل صارت تصدر تصريحات غربية، أهمّها أميركية، بدأت خافتة ثم تناسلت علناً، تردّد: نلتزم بضمان التوازن التسليحي بين إسرائيل والدول العربية... كل الدول العربية.
9 ـــ ومع انزواء موسكو عن «طلب القرب» من إسرائيل، مطالع الخمسينات، صارت الأخيرة مسؤولية ورصيداً غربيين. بداية التبني كان أمر واشنطن لألمانيا الغربية، عام 1952، بتزويد إسرائيل ببلايين الماركات، تعويضاً عن «المحرقة»، ولتكون مدداً لا ينقطع لدزينة أعوام. ثم صار اهتمام واشنطن منصبّاً على «تطبيع» وضع الكيان الجديد وسط منطقته، أي عقد الصلح بينه وبين العرب. كان ذلك شرطاً رئيساً لجون فوستر دالاس على عبدالناصر، لمّا قابله في القاهرة في أيار / مايو 1953، لقاء عونه على إجلاء القوات البريطانية عن قاعدة القنال، وتزويد جيشه بالسلاح، وتمويل مشروع السد العالي. ناور عبدالناصر بالطول والعرض، كي لا يخسر ضغط واشنطن على لندن كي تنهي احتلالها للقنال، وبأمل نيل السلاح الموعود والسدّ المرتجى، فماشى محاولات الوساطة الأميركية متمسّكاً بشرطين: تنفيذ قراري 181 للتقسيم و194 لعودة اللاجئين. وفيما السعي جارٍ، كان هناك ممانعون له، وبضراوة. كان أيزنهاور قد اضطر بن غوريون أن يستقيل من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب غارة قبية / الضفة الغربية، في تشرين الأول / اكتوبر 1953. حلّ الحمائمي موشي شاريت محلّ الصقر المعتزل / المعزول، وكان تولّيه غبّ الطلب لمسعى الصلح. لكن المؤسسة العسكرية ـــ الأمنية في إسرائيل، الخاضعة لنبيّها بن غوريون، المنكفئ ـــ ظاهراً ـــ في مستوطنة سيدي بوكر في النقب، كان لها رأي آخر: إن الصلح مبتسر ومبكّر، وينبغي له أن ينتظر حتى يشتد ساعد الكيان ويكون أقل اضطراراً لتقديم التنازلات المطلوبة. ارتكبت جماعته حماقة عمرها صيف 1954، حين أقدم جواسيسها ـــ من «أمان» / الاستخبارات العسكرية ـــ على محاولة تفجير منشآت أميركية وبريطانية في مصر، أملاً في تخريب العلاقات المصرية ـــ الغربية. سميت تلك بفضيحة لافون. لم يكتفِ الصقور بذلك، بل ضاعفوا جهد الإعاقة بشنّ تساحل غارة كبيرة على موقع عسكري مصري في غزة، في 28 شباط / فبراير 1955. سبق ذلك بأسابيع، عودة بن غوريون من معتزله، وزيراً للدفاع. وبتشجيع من نظراءَ صقور داخل مجمع الاستخبارات الأميركي: تحديداً، جيمس جيسوَس أنغلتون (مدير قسم مكافحة التجسس، الصهيوني)، تمكّن صقور إسرائيل من إيقاف مساعي الصلح الأميركية، ثم عزل خصومهم الحمائم بإقالة وزارة موشي شاريت في حزيران / يونيو 1956، وتولّي بن غوريون رئاسة الحكومة من جديد.
10ـــ وبرغم انزعاج واشنطن الفائق من تواطؤ إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا، في حرب السويس، والذي وصل إلى حدّ إجبارها على الانسحاب من سيناء وغزة، في آذار / مارس 1957، إلّا أنّ من تأثيرات الحرب تلك على تفكيرها كان إعجابها بأداء «تساحل» في الأيام الثلاثة الأولى لها. رفع ذلك تقييم البنتاغون لـ«تساحل» إلى مرتبة أعلى، وإن بقي بعدُ تحت سقف النأي عن اعتماده حليفاً جونيور، للأسباب السالفة ذاتها.
11 ـــ كانت سنوات الانفراج في العلاقات العربية ـــ الأميركية (بين خريفي 1958 و1962) معيقاً رئيساً لمزاولة إسرائيل دور رصيد واشنطن الاستراتيجي إقليمياً. ليس ذلك فحسب، بل شهدت سنوات كينيدي الثلاثة سعيه الدؤوب إلى حصر النشاط النووي الإسرائيلي تحت عتبة القدرة النووية.
لقد وصل الأمر به إلى أن أشار على بن غوريون بالاستقالة من رئاسة الحكومة، في حزيران / يونيو 1963، محمّلاً إياه مسؤولية التجاوز النووي. صحيح أنّ كينيدي كان أول من كسر قاعدة الامتناع عن تسليح إسرائيل مباشرةً، عندما زوّدها ببطاريات صواريخ «هوك» للدفاع الجوي في آب / أغسطس 1962، بحجة تهديد مصر الصاروخي لإسرائيل (قبلها بشهر، أجرت مصر اختباراً صاروخياً لنماذج سبقتها إسرائيل إليها بعام)، لكنّ متغيّراً رئيساً دخل على المشهد في خريف عام 1962، وهو حرب اليمن. وبينما حاول كينيدي التوصل إلى تسوية تكفل انسحاب القوات المصرية المساندة للجمهوريين، مقابل وقف الإمداد السعودي للملكيين، ما بين آذار / مارس وتشرين الأول أكتوبر 1963، وبغير نجاح كبير بعد، فقد قلب خليفته، ليندون جونسون الأمر عاليه سافله، حال تولّيه الرئاسة في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 1963. لقد اعتمد باقة سياسات تأخذ العلاقة مع عبدالناصر من الانفراج إلى الصدام، وشملت: استبقاء الجيش المصري في اليمن، بغية استنزافه بحرب مرتزقة (كومر)، قطع صادرات القمح بغية التركيع، إشاحة الوجه عن المسعى الإسرائيلي لامتلاك القدرة النووية، وصولاً إلى السلاح النووي، وتسليح إسرائيل بأسلحة هجومية متقدمة.
12 ـــ من هنا، فقد كان عام 1964 عام ارتقاء مكانة المشروع الإسرائيلي، من خانة طالب ضابط إلى فئة ضابط احتياط. كان أصحابه في انتظار توفّرهم على القدرة النووية، حتى تكون أوراق اعتمادهم، ضابط ركن عامل، قد اكتملت؛ أمرٌ تحقّق لهم عشية حرب 1967. ما تحقّق لهم عند ذلك المفصل أيضاً، كان توفرهم على تعلّة شن حرب. لقد تحيّنوها لحين، فلّما لاحت اهتبلوها بكل الزخم. وافق جونسون على المهمة آخر أيار / مايو 1967. كانت، باختصار، حصر الجيش المصري بين خط الحدود وخط العريش ـــ رأس محمد، لتكون منطقة قتل له، ولتوفّر هذه الهزيمة إسقاط جمال عبدالناصر ونظامه. لكن ما أحرزته إسرائيل، في أيام ستة، فاق تصوّر أحد؛ وعليه، صار تساحل وإسرائيله لا ضابط ركن عامل فحسب، بل شريكاً / حليفاً في صلب هيكل القيادة.
13 ــ لا حاجة إلى تشريح مسيرة العلاقة الأميركية ـــ الإسرائيلية، منذ عام 1967ولتاريخه فهي تشرح نفسها. يكفي القول إنها انطلقت من هدف بؤري، هو إسقاط عبدالناصر، لتصل إلى وضع اليد على جغرافيا، احتُبست فلسطينها رهينة حتى يقوم أهلوها بأمرين: أ ـــ إنهاء الصراع، أي قبول السردية الإسرائيلية له وإسقاط تلك العربية / الفلسطينية، أي الاعتراف بـ«حق الشعب اليهودي في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية». ب ـــ الاكتفاء بكيان بانتوستاني ملحق بإسرائيل وحامٍ لها، ونسيان حق العودة. وما زلنا عند تلك النقطة بعد ما ينوف عن نصف قرن من عام 1967.
طيب، لماذا جرى ما جرى وتحوّلت واشنطن من متوجّسة من قيام إسرائيل، ثم نائية عن تبنيها، إلى راعٍ لها وضامن ثم حليف... وهل من سبيل لاستعادة أو إعادة إنتاج فترة الانفراج / الوفاق التي سادت ما بين عامي 1958 و1962؟
في الجواب على الشقّ الأول، كان السعي الأميركي للهيمنة على المنطقة العربية، سواء دفعاً لـ«خطر» الوحدة العربية على مصالحها، و / أم في سياق الحرب الباردة مع السوفيات، هو ديدن قبول أوراق اعتماد إسرائيل أداة تأديب، أو عقاب أو محض تهديد.
أما الشقّ الثاني، فإمكانيّته تتوقف على تغيير موازين القوة؛ فلّما كان للعرب قطب مركزي فاعل وصاحب قرار مستقلّ تعايشت الولايات المتحدة معه قبولاً، ولو على مضض.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2020/03/27