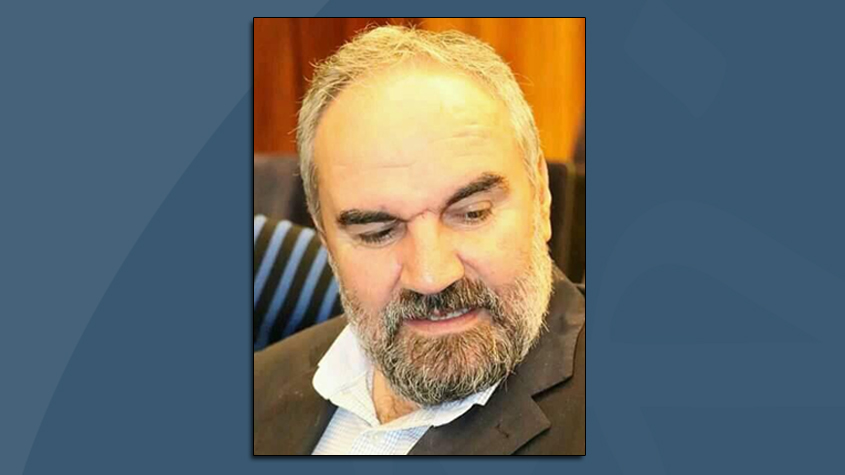النظام الأميركيّ والعنصريّة
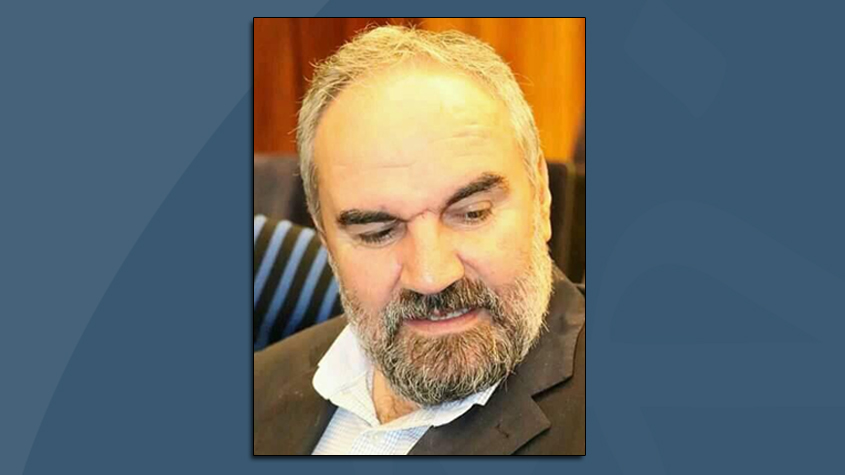
نايف سلوم
لم تُخلق المشكلة العنصرية في الولايات المتحدة كنتيجة للرأسمالية الاحتكارية، وإنما هي موروثة من النظام العبودي في الجنوب القديم. ومع ذلك، فقد طرأ على طبيعة المشكلة تغيّر شامل خلال فترة الرأسمالية الاحتكارية. وفي عالم تنفض فيه الأجناس الملونة عن نفسها أغلال الظلم والاضطهاد، لا بل تتقدم إلى صدارة المشهد الدولي (الصين الاشتراكية) يبدو جلياً أن مستقبل الولايات المتحدة سوف يتأثر إلى درجة كبيرة، وربما إلى درجة حاسمة، بتطور العلاقات العنصرية داخلها.
وكما يقول غونار ميردال في دراسته الدقيقة لمعضلة العنصرية في الولايات المتحدة، إنه ينبغي البحث عن دينامية العلاقات العنصرية في الولايات المتحدة في التوتر القائم بين تعصّب الجنس الأبيض و»العقيدة الأميركية» في الحرية والمساواة، التعصب الأبيض تجاه الزنوج والتمييز وانخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي كل هذا يتفاعل تفاعلاً مستمراً، فكلما زاد التعصب زاد التمييز، وكلما ازداد التمييز زاد انخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي. وكلما زاد هذا الانخفاض زاد التعصب في حلقة حلزونية مفرغة. وعلى أيّ حال يجب دراسة مصير العنصرية الأميركية بالارتباط مع الهيكل الأساسي للرأسمالية الاحتكارية في المجتمع الأميركي.
إن التحيّز والاضطهاد العنصرييْن كما هما قائمان الآن في العالم يكادان ينحصران في موقف نفسي للبيض ترجع جذوره إلى حاجة المستعمرين الأوروبيين منذ القرن السادس عشر إلى تبرير ما يقومون به من سلب واستغلال مستمريْن لضحاياهم الملوّنين في كل أنحاء الكرة الأرضية. وعندما دخل نظام الرق إلى الجنوب الأميركي جاء معه بالطبع التمييز العنصري، وانتقلت عملية التبرير الإيديولوجي إلى أيْدٍ أكثر حنكة ومكراً منها في أي مكان آخر في العالم. ولقد ظل الشعب الأميركي، منذ عهد الاستعمار، هدفاً لحملة منظمة ومستمرة من الدعاية التي تروّج أفكاراً عن سمو البيض وانحطاط الزنوج.
كان من السهل دائماً اصطناع الدليل لإثبات النظرية القائلة بسمو البيض وانحطاط الزنوج، ذلك أن الزنوج، بحكم تكبيلهم في إسار العبودية وحرمانهم من كل فرص المشاركة في مزايا الحياة العصرية المتحضّرة. كانوا يظهرون دون ريب، في صورة منحطة في جميع النواحي، وكان الادّعاء بأن هذا الانحطاط الملموس في الواقع والظاهر يرجع إلى صفات عنصرية موروثة كفيلاً بإقناع أولئك الذين كانوا يودون تصديقه. ولم يكن البيض وحدهم هم الذين قبلوا بهذا الادعاء، فلقد أمكن النجاح في غسل أدمغة الكثيرين من الزنوج ودفعهم إلى الاعتقاد في صدق انحطاطهم الوراثي. فكان هذا الإحساس بالدونية وتفاهة الشأن من أهم الدعامات التي ثبّتت النظام العنصري. لم تدخل الطبقة الحاكمة في الشمال الحرب الأهلية لكي تحرر العبيد كما يعتقد الكثيرون خطأ، وإنما شنت حرباً لكي تضع حداً لآمال الفئة الحاكمة في الجنوب، أصحاب العبيد، والتي كانت تود الفكاك والتحرر مما كان يعتبر في جوهره علاقة استعمارية مع نظام رأس المال الشمالي. أما إلغاء الرق فلم يكن سوى نتيجة ثانوية للصراع وليس هدفه الرئيسي. وعلى الرغم من ترانيم «إعادة البناء» لم تكن رأسمالية الشمال تنوي تحرير الزنوج، فما كادت تلك الرأسمالية تفلح في إخضاع أصحاب المزارع في الجنوب حتى سمحت لهم في سعادة باستئناف استغلالهم لقوة العمل الأسود والتي استطاعت تلك الرأسمالية بدورها استغلاله. وكانت المصالحة الغريبة بينهما سنة 1870 بمثابة اعتراف ضمني من الجانبين بقبول تحديد الوضع الاستعماري للجنوب مع ترك القلة الحاكمة فيه تتمتع باستغلال الزنوج في مقابل دفع الجزية لرأس المال الشمالي. وحلّ محل النظام العبودي العمل المأجور ونظام المزارعة والسخرة.
وعندما حاول الزنوج الانتفاع من حريتهم الشرعية لكي ينظموا أنفسهم بالاشتراك مع فقراء البيض، في الحركة الشعبية «حزب الشعب»، جاء رد أصحاب المزارع مستخدمين العنف وفرض التفرقة قانوناً، وهو ما عُرف باسم حركة «جيم كرو». وفي نهاية القرن التاسع عشر كان اضطهاد الزنوج واستغلالهم قد بلغا درجة لا تقل سوءاً عما بلغته تحت النظام العبودي، كما بلغت الدعاية العنصرية حداً لا يقل دهاء وفعالية عما كانت عليه من قبل. بل إنها حقّقت في الشمال نجاحاً أكبر لأنها لم تعد حينئذٍ تحمل سمة العبودية السافرة.
كانت الغالبية العظمى من زنوج الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى من طبقة الفلاحين، ومع أن زحفهم للخروج من الجنوب قد بدأ سنة 1880 إلا أن 80% منهم كانوا يدخلون ضمن الدولة التعاهدية القديمة (دولة الجنوب أثناء الحرب الأهلية)، وكان 90% منهم لا يزالون يقيمون في مناطق ريفية. وعلى وجه العموم فإن الزنوج لم يلعبوا إلا دوراً ثانوياً في الاقتصاد الشمالي قبل عام 1914.
الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يمارسها المجتمع الرأسمالي الاحتكاري تضاعف من حدة التعصب العنصري القائم وبالتالي من حدة التفرقة والعزل
تُعتبر الحرب العالمية الأولى النقطة الفاصلة التي انتهى عندها بصفة فعلية نظام إمداد سوق العمل في الولايات المتحدة باحتياجاتها من المهاجرين من أوروبا والمكسيك وآسيا وكندا. وكان من الضروري الالتجاء على نطاق واسع إلى الفائض الكبير من الأيدي العاملة التي تراكمت لبعض الوقت في المناطق الريفية، وخاصة في الجنوب.
حدثت حركة الهجرة الكبيرة من الريف إلى المدينة خلال الحرب العالمية الأولى بفعل الإنتاجية المتزايدة في الزراعة كنتيجة للمكننة واستخدام وسائل الزراعة الكثيفة، فتخلّف الطلب على العمل الزراعي. إن الزيادة الهائلة في الطلب على العمل في المدن خلال الحرب شكّلت قوة جذب كبيرة للعاطلين عن العمل في الريف. وهنا تبين للولايات المتحدة التي كانت تعتمد دائماً على الهجرة من الخارج، وبشكل مفاجئ، أنها تستطيع الاعتماد على نفسها بالالتجاء إلى فائض الأيدي العاملة في مناطقها الريفية، تماماً كما كانت أوروبا تفعل منذ بداية الثورة الصناعية (1770).
ولعل ما يدعو للسخرية هو أن يؤدي هذا التغيّر الجوهري في تيار الهجرة إلى انخفاض الحاجة إلى تصعيد مستويات العمل غير الماهر وشبه الماهر إلى عمل ماهر، ذلك أنه بعد عام 1924 أصبح تسلّق السلم الاقتصادي بالنسبة إلى المواطن الذي ينزح من الريف إلى المدن أشقّ مما كان بالنسبة إلى زميله النازح من أوروبا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى.
إن التحول في إشباع الطلب على العمل غير الماهر وشبه الماهر بالاعتماد على مصادر محلية بدلاً من المصادر الخارجية كان معناه نزوح الزنوج من ريف الجنوب إلى مدن الشمال. أما أكبر موجة للنزوح فقد جاءت مع الحرب العالمية الثانية واستمرت منذ ذلك الوقت.
استقر جميع الذين نزحوا من الجنوب تقريباً في مدن الشمال والغرب الأميركي. لكن لم تكن تلك هي الحركة الوحيدة للزنوج، ففي داخل الجنوب ذاته كانت هناك هجرة مستمرة من الريف إلى المدن. وكانت النتيجة بين 1910-1960 تحول الزنوج من فلاحين يرتبطون بمنطقة جغرافية معينة إلى قطاع هام من الطبقة العاملة في الحواضر، ومع بداية الستينيات فإن ثلاثة أرباع الشعب الزنجي بات يُعتبر من سكان المدن.
كان لا مفرّ بالطبع من أن يكون دخول الزنوج في الاقتصاد الحضري عند أسفل الدرجات، إذ كانوا لدى وصولهم إلى المدينة أكثر الناس فقراً وجهلاً وأقلهم دراية ومهارة. وكان العبء فوق كواهلهم عبئاً مزدوجاً: عبء التحيز والتمييز العنصرييْن الموروثيْن، وعبء التحيز والتمييز اللذين كانت تواجههما كل فئة من القادمين الجدد الفقراء. لهذا لم يستطيعوا أن يقتفوا آثر المهاجرين القدامى في تسلق السلم الاقتصادي وفي التخلص من أحيائهم المعزولة التي كانوا يقطنونها في البداية عند وصولهم إلى المدينة.
من المهم أن نعلم أن وضع الزنوج ليس نتيجة فقط للحقائق التي لا يشك فيها أحد وهي أنهم في المتوسط أقل تعليماً حيث يتركّزون في المهن غير الماهرة أو شبه الماهرة، بل إن وضعهم المهني يكون أدنى من البيض حتى ولو كانوا في مستواهم الدراسي نفسه! كما أنهم يتقاضون أجوراً أقل عندما يقومون بأداء العمل نفسه الذي يقوم بأدائه البيض. وبالنسبة إلى هاتين الناحيتين، فإن الغبن النسبي للزنوج يأخذ في الاتساع كلما ارتفعت أهمية المهنة وزاد مقدار الدخل. وهكذا فإن الزنوج لم يحققوا تقدماً في وضعهم المهني (باستثناء قلة من المحظوظين) مقابل البيض منذ عام 1940، كما أن مركزهم من حيث الدخل لم يتحسن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يضاف إلى ذلك أن مركزهم في بعض النواحي الحيوية قد ظل يتدهور تدهوراً واضحاً، ونشير هنا بصفة خاصة إلى حالة البطالة وظروف السكن. ففي بيانات التعداد لعشر مدن كبرى تبين أن نطاق العزل الإسكاني للزنوج قد أخذ في التزايد المطّرد منذ عام 1910 وهو الوقت الذي كان نزوحهم فيه إلى المدن قد بدأ يأخذ طابعاً جماهيرياً واسعاً. في حين أخذ هذا العزل بالنسبة إلى جماعات المهاجرين من الخارج في التناقص. وإذا تساءلنا عن القوى والأنظمة الاجتماعية التي أرغمت الزنجي على القيام بدور المهاجر الدائم الذي يدخل المدينة عند أسفل السلم الاقتصادي ليبقى في مكانه زمناً بعد آخر، نقول إن ثلاث مجموعات أساسية من العوامل تفعل ذلك وهي أولاً مجموعات هائلة من أصحاب المصالح الخاصة التي تستفيد، بطريقة مباشرة وسافرة، من استمرار وجود قطاع معزول من الطبقة العاملة. وثانياً، أن الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يوجدها المجتمع الرأسمالي الاحتكاري تضاعفت بدلاً من أن تُخفف، من حدة التعصب العنصري القائم وبالتالي من حدة التفرقة والعزل. وثالثاً، أنه كلما نمت الرأسمالية الاحتكارية، قلّ الطلب بمعناه المطلق والنسبي على العمل غير الماهر وشبه الماهر. وهو اتجاه يتأثر به الزنوج أكثر مما تتأثر به أية جماعات أخرى. كما يزيد من حدة انخفاض مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا تتفاعل جميع هذه العوامل لتدفع بالزنوج دفعاً مستمراً نحو قاع الهيكل الاجتماعي ولتحكم عليهم الرتاج داخل أحيائهم الفقيرة المعزولة.
تتأصّل في الرأسمالية الاحتكارية الجذور العميقة لكل هذه العوامل التي ناقشناها وهي المصالح الخاصة المستفيدة، والاحتياجات النفسية الاجتماعية، والتحولات التكنولوجية، كذلك تتضامن هذه العوامل في تفسير الحقيقة الواضحة وهي أن الزنوج لم يتمكنوا من الارتفاع فوق مستوى الحضيض في المجتمع الأميركي. والحق أن هذه العوامل قد بلغت درجة من الانتشار والفعالية إلى حد يبعث على التفاؤل في دهشة كيف أن حالة الزنوج لم تصل إلى مستوى الكوارث. أما السر في ذلك فلا يفسره إلا وجود قوى تعمل في الاتجاه المضاد. إن حادثة مقتل الزنجي جورج فلويد خنقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض تبين لنا في الوقت الحاضر أن الجماهير الزنجية في الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع أن تضع آمالها في الاندماج في المجتمع الأميركي كما هو الآن، ولكنها تستطيع أن تأمل في أن تصبح واحداً من العوامل التاريخية التي ستعمل على الإطاحة به، لكي تضع في مكانه مجتمعاً آخر لا تتقاسم فيه حقوقاً مدنية هي في أحسن الأحوال فكرة بورجوازية، بل تنعم في ظله بكامل حقوقها.
اعتمدنا بشكل أساسي على كتاب: رأس المال الاحتكاري، تأليف بول باران، بول سويزي، ترجمة حسين فهمي مصطفى، الهيئة المصرية للتأليف والنشر.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2021/07/20